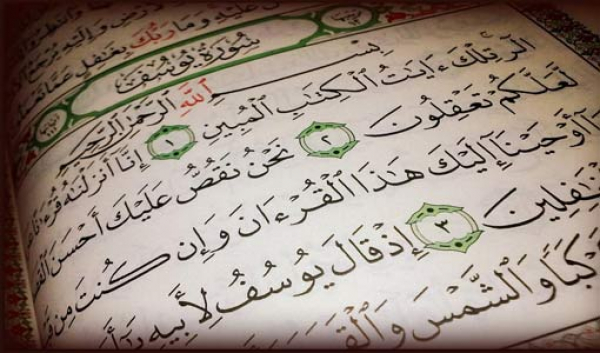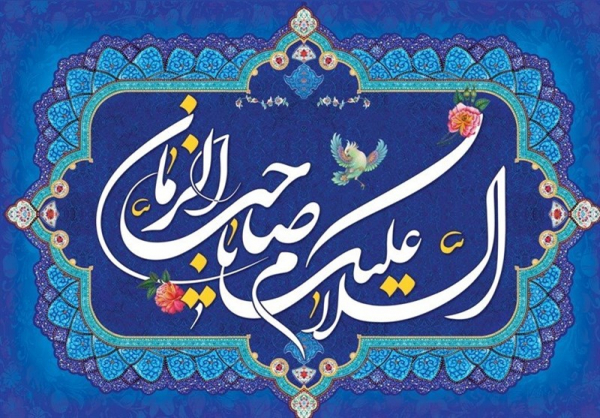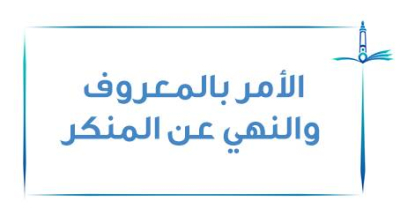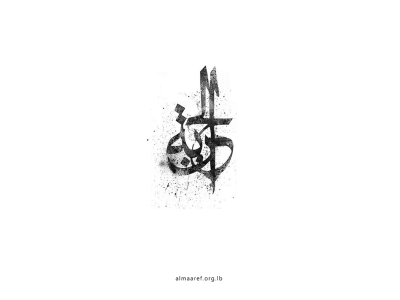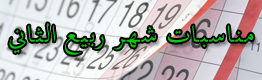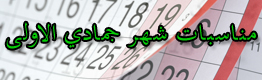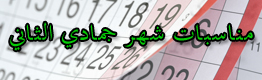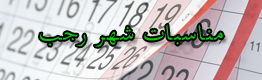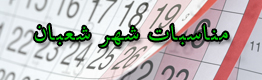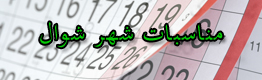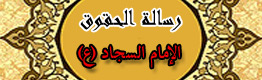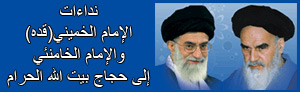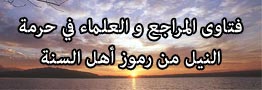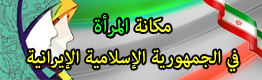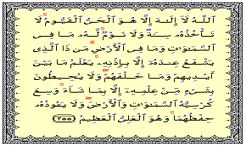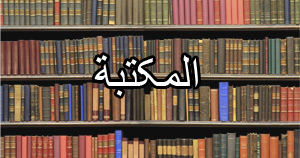emamian
باقري لمورا: يمكن التوصل الى اتفاق في فيينا لو تحلت اميركا بالواقعية
اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني جدية وعزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على الوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا، مصرحا بانه من الممكن الوصول الى الاتفاق لو تحلت اميركا بالواقعية.
جاء ذلك خلال اجتماع مساعد مسؤول السياسة الخارجية ومنسق مفاوضات فيينا انريكي مورا في طهران اليوم الاحد، مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني.
وفي الاجتماع تبادل الجانبان وجهات النظر حول احدث اوضاع مفاوضات رفع الحظر في فيينا، وتباحثا حول القضايا المتبقية في هذه المفاوضات.
واكد باقري جدية وعزم الجمهورية الاسلامية الايرانية للوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا وقال: لو تحلى الجانب الاميركي بالواقعية فمن الممكن الوصول الى الاتفاق.
وقدّم مورا خلال الاجتماع تقريرا حول احدث مشاوراته مع سائر الاطراف.
وسيواصل باقري ومورا الاتصالات والمشاورات الوثيقة خلال الايام القادمة ومن المقرر ان يلتقي مورا وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم ايضا.
وكان مورا قد اعلن في تغريدة كتبها في حسابه على موقع تويتر الجمعة بانه سيزور طهران السبت لاجراء محادثات مع مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني وقال: سنسعى من اجل ردم الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.
واضاف: ينبغي علينا ايصال هذه المفاوضات الى نهايتها. الكثير من الامور في خطر.
وبعد ذلك اوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع بان مورا سيزور واشنطن بعد طهران من اجل الوصول بمفاوضات فيينا الى نتيجة نهائية.
وتاتي زيارة مورا الى طهران وفق تفاهم مسبق وتم الاعلان سابقا بانه من المتحمل ان يلتقي بعض كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية بناء على طلب منه.
ويوم امس قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اننا قريبون من نقطة الاتفاق ، ولكن ما زالت هناك قضايا قليلة ومهمة ومن المقرر أن يصل السيد مورا إلى طهران في غضون ساعات وتاتي زيارته في اطار تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن .
واضاف عبداللهيان في مقابلة مع القناة السادسة بالتلفزيون الايراني حول المفاوضات الاخيرة في فيينا : الاتفاق لن يتجاوز الاتفاق النووي . لقد تمكنا من قطع أشواط كبيرة في مجال رفع الحظر .
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تواصل مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر لكنها لن ترهن مستقبل البلاد بنتائجها
وأضاف أمير عبداللهيان أنه تم التوصل في فيينا إلى تفاهمات هامة بشأن إلغاء الحظر، لكن المفاوضات لم تبلغ نقطة التوصل لاتفاق، مشددا على أن طهران تسعى إلى الوصول لاتفاق جيد وقوي ومستدام يلغي الحد الأعلى من الحظر، وتطالب برفع أشكال الحظر بناء على اتفاق 2015 ، بما يشمل تسهيل التعاملات المالية بين إيران وبقية العالم.
في بيتنا.. حِصة حُب
أيها الوالد الكريم.. الحب وحده لا يكفي، الإعلان عن هذا الحب والاعتراف به وإظهاره بطرق مختلفة أهم في عيون أبنائك، لذلك فإنّ من الضرورة أن تعطيهم يومياً "حصة حب"، تفتح لهم فيها قلبك، وتفصح لهم عن حبك، وتتركهم يشعرون بعطفك وحنانك، حتى تنشرح لك صدورهم، وتميل إليك قلوبهم وعقولهم... لا يهم كم من الوقت تستغرقه هذه الحصة؛ المهم هو كيفية قضاء هذا الوقت مع أبنائك، لذلك فإننا نقدم لك – فيما يلي – بعض الوسائل العملية التي تناسب حصّة الحبّ اليومية...
1- من فضلك.. أعطني هدية: من الجميل أن نحرص على تبادل الهدايا مع أصدقائنا وأحبابنا، ولكن ما الذي يجعلنا نحرم أبناءنا من روعة هذه الهدايا وجمالها؟! هل ننتظر حتى يقول الابن لأبيه: من فضلك أعطني هدية؟!.. إنّ أبناءنا هم أحوج الناس إلى هذه الهدايا وأحقهم بها.
2- أخوك أفضل منك: يلجأ الوالدان أحياناً لدفع الابن إلى السلوك الحسن عن طريق مقارنته بإخوته، فيقول له أبوه: أخوك أفضل منك لأنّه يطيعني ولا يعصي أمري، أو لأنّه يستذكر دروسه ولا يكثر اللعب... وهذا أسلوب غير صحيح لتشجيع الابن، لأنّه يخلق من الغيرة بين الأبناء، وربما تطور لشيء من الكراهية بينهم، ويشعر الابن بأنّ الأبوين يحبان أخاه بدرجة أكبر مما يحبانه هو، وربما يدفع هذا الشعور الابن إلى الانتقام من أخيه أو إيذاءه.
والأفضل إذا أردنا أن نشجع الابن فلنقل له: أنت كنت أفضل بالأمس من اليوم، إننا نريدك أن تكون متقدماً دائماً وحسن السلوك، فلنقارن الابن بنفسه في الأوقات المختلفة، فهو بالتأكيد تارة يكون مطيعاً وتارة أخرى يكون غير ذلك، ولنعلم أنّ الابن لديه حساسية شديدة من ناحية إخوته ومعاملة أبويه لهم، فلا نحاول أن نستأثر أحداً من الأبناء بشيء – مهما كان تافهاً – على الآخرين، حتى لو بالكلمة أو البسمة أو النظرة أو السلام.
3- المدح والثناء.. طريق البناء: في بعض الأحيان يفشل الأب (أو الأُم) في توصيل الحب للابن، لأنّه يركز أساساً على أخطائه ويتناسى محاسنه، أو يتحدث عن ميزات للآخرين لا تتوافر فيه، وهذا خطأ في أسلوب التربية، لأنّ مدح الابن له أثر فعّال في نفسه؛ فهو يحرّك مشاعره وأحاسيسه، ويجعله يسارع – بكلِّ جديّة وارتياح – إلى تصحيح سلوكه وأعماله.
أيها الوالد الكريم.. إذا كنت تريد أن يحبك أبناؤك؛ فأحبّهم أنت أوّلاً واجعلهم يشعرون بهذا الحب، ولكي تنجح في هذه المهمة عليك أن تمدحهم، اختر شيئاً جميلاً فيهم وحدثهم عنه، ولن تعْدم ذلك الشيء، فالناس يختلفون ويتفاوتون ولكنه لا يمكن إلا أن تجد شيئاً جميلاً في كلِّ فرد منهم، وهذا ما يؤكده "ديل كارنيجي" في كتابه " كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس" حيث يقول: إنّ الناس يحبون أن تمتدح الناحية الجميلة فيهم، وأنا أذكر أنني ذهبت إلى مكتب البريد يوماً لأرسل خطاباً، ووقفت أنتظر دوري في الصف المنتظم لأسجل الخطاب، فلاحظت أنّ الموظف المنوط به التسجيل متبرِّم بعمله، ملول منه: يزن المظاريف، ويناول الطوابع، ويرد باقي النقود، ويحرر الإيصالات... حلقة مفرغة من العمل المتشابه الذي عهِدَه سنة بعد أخرى، فقلتُ في نفسي: فلأحاول التحبب إلى هذا الشاب، وبديهي أنني إذا أردت أن أتحبب إليه فيجب أن أقول له قولاً لطيفاً، لا عن نفسي وإنما عنه هو، وساءلت نفسي: ترى ما الذي يستحق أن أبدي إعجابي به؟! والإجابة عن هذا السؤال عسيرة أحياناً، خصوصاً حيال الغرباء، ولكنها في تلك المناسبة بالذات كانت ميسورة، فسرعان ما لمحت شيئاً اعتزمت أن أبدي له إعجابي به... وبينما الشاب يزن مظروفي قلت له في لهجة مخلصة: لكم أتمنى لو كان لي مثل شعرك الفاحم اللماع، فنظر إليَّ الشاب وهو نصف ذاهل، وقد أشرق وجهه سروراً وقال في تواضع: حقاً؟ إنّه ليس في مثل بهائه الأوّل، فأكدت له أنّه ما زال جميلاً أخاذاً، وقد سُرَّ لذلك أيما سرور وقال: إن كثيرين قبلي قد أبدو إعجابهم بشعره... وأحسب أنّ هذا الشاب قد ذهب إلى منزله ظُهْر ذلك اليوم وهو يكاد يسير على الهواء، وأظن أنّه ما إن دخل إلى منزله حتى قص ما جرى بيني وبينه على زوجته، وأظن أنّه تطلَّع إلى صورته في المرآة وقال لنفسه: حقاً... إنّه شعر جميل...
أيها الوالد الكريم.. أين ينبغي لك ولي أن نبدأ بتطبيق هذه الوصفة السحرية: المدح والثناء والتقدير؟ لماذا لا نبدأ في عقر دارنا؟ أنا لا أعرف مكاناً آخر أشد من بيوتنا حاجة إلى ذلك، ولا أشد منها حرماناً...!!
4- اسمعني.. إن كنت تحبني[1]: لا أحد يسمعني.. جملة تتردد على لسان الكثير من الأبناء، خصوصاً صغار السن منهم، وسواء وصلت هذه الجملة إلى آذان الآباء أو لم تصل؛ فإنّ الطفل يرددها دائماً علانية أو بينه وبين نفسه؛ لأنّه لا ينتظر من الكبار أن يسمعوه فحسب؛ بل ينتظر منهم الاهتمام بحديثه والتفاعل معه، وهذا التفاعل إنما يظهر من خلال تعابير الوجه المختلفة بما توحيه من انفعالات؛ سواء كانت الدهشة أو الموافقة أو حتى الرفض، ولا يكفي الإنصات الصامت فحسب، لهذا يجب علينا – كآباء – أن نتيح الفرصة لأبنائنا ليتحدثوا إلينا، نعم قد يبدو حديثهم مملّاً أحياناً ومكرراً أحياناً أخرى، لكن السماح لهم بالتعبير عما بداخلهم عامل هام لنموهم نفسياً وخلقياً وعقلياً.
أيها الوالد الكريم... تخيل أنك طفل صغير عائد من مدرسته فرحاً، ثمّ دخلت المنزل فوجدت والدك، فأخذْتَ تحكي له بشغف عن شيء ما حدث في مدرستك أو في طريق عودتك، فقاطعك والدك بقوله: أنا مشغول ولا أستطيع سماعك... فما هو إحساسك عندها؟!... يا له من إحباط كبير، وكثيراً ما نفعله مع أبنائنا، ولا نشعر أننا أحرجناهم أو قطعنا عليهم لحظة الشوق إلينا وإلى محادثتنا...!!!
أيها الوالد الكريم... نعلم أنّ مشاغلك وأعمالك كثيرة، ولهذا قد لا تستطيع سماع أبنائك، أو قد ينفد صبرك أثناء استماعك لهم، ولكن حرصك على سلامة نفسية فلذات أكبادك يجب أن يكون شغلك الشاغل، فاستمع لهم دون نقد أو مقاطعة أو إعراض، ودون إصدار أحكام مسبقة على ما يقولون، فإنّ لذلك أثراً عظيماً في نفوسهم.. واعلم أنّه إذا لم تحسن الاستماع لأبنائك فهناك آخرون يحسنونه، لا تدري بالضبط مَنْ هم...!!!
5- ابتسم من فضلك: إنّ تعبيرات الوجه تتكلم بصوت أعمق أثراً من صوت اللسان، وكأنى الابتسامة تقول لك عن صاحبها: "إني أحبك، إني سعيد برؤيتك"... ولا تحسب أننا نعني بالابتسامة مجرد "علامة" ترتسم على الشفتين لا روح فيها ولا إخلاص، كلا!! فهذا لا تنطلي على أحد، وإنما نتكلم عن الابتسامة الحقيقية التي تأتي من أعماق نفسك، تلك هي الابتسامة التي تفتح مغاليق النفوس، وتنفذ إلى أعماق القلوب.
كما أخبرنا رسول الله (ص) أن تبسّمنا يضيف إلى ميزان الحسنات ثواب الصدقات، روى الترمذي عن أبي ذر (رض) قال: قال رسول الله (ص): "تبسمك في وجه أخيك لك صدقة". وعن تأثير الابتسامة الصادقة في نجاح صاحبها يقول "ديل كارنيجي" في كتابه "كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس": طلبتُ من تلامذتي أن يبتسم كلّ منهم لشخص معيّن كلّ يوم في أسبوع واحد، ثمّ يراقب أثر تلك الابتسامة، وهذا ما نقله إليَّ "وليم شينهارت" الوسيط في سوق الأوراق المالية بمدينة نيويورك: "إنني متزوج ولي أولاد، لكنني قلّما ابتسمت لزوجتي، بل قلّما حدّثتُها سواء على مائدة الإفطار أو بعد عودتي من العمل، فأنا منشغل دائماً، وقد سارت حياتنا الزوجية على وتيرة آلية، حتى طلبت أنتَ منّى أن أبتسم لشخص ما، فآثرت أن يكون ذلك الشخص هو زوجتي، وجلست في صبيحة اليوم التالي إلى المائدة؛ فقلت مبتسماً: صباح الخير يا عزيزتي، ولم تندهش المرأة فحسب، بل انّها ذُهلت فعلاً، لكني أسرعت فوعدتها أن تنتظر منّي مثل هذه التحية والابتسامة الرقيقة كلّ يوم، فهل تدري ماذا كانت النتيجة؟! لقد اكتشفتُ سعادة جديدة لم أذق مثلها طوال الأعوام الأخيرة، وحفّزني ذلك على الابتسام لكلِّ من أتعامل معه؛ فصرت أبتسم لعامل المصعد، والعامل في شباك التذاكر، والزبائن الذين أعمل معهم في البورصة، وصار الجميع يبادلونني التحية، ويسارعون إلى خدمتي... لقد شعرت بأنّ الحياة صارت أكثر إشراقاً وأيسر منالاً، وقد زادت أرباحي الحقيقية بفضل تلك الابتسامة، وعجبت من سبب غفلتي عن ذلك طوال المدة السابقة".
الكاتب: عبدالله محمّد عبدالمعطى
المصدر: كتاب كيف تكون أباً ناجحاً (حلقات تربوية هادفة)
[1]- في أمريكا أصبح الاستماع أحد الواجبات التي يفرضها القانون على الآباء تجاه الأبناء، ففي حالات الطلاق بدأت ولاية "ميريلاند" الأمريكية تجربة جديدة في نوفمبر 1993م تقضى بأن يحضر الآباء والأُمّهات – إجبارياً وبحكم المحكمة – ندوات مفتوحة يستمعون فيها للأبناء وهم يحكون تجاربهم الشخصية حول تأثير الطلاق وانفصال الأبوين على نفسيتهم، وما يعقبه من شعور بالذنب والفشل والغضب وعدم الثقة، هذه التجربة الرائدة، تمّ تعميمها في 12 ولاية أخرى على مستوى الولايات المتحدة.
القيم في القرآن الكريم.. مفهوماً
القِيَمُ جمع قِيمَة، وجذرُها قَوَمَ، ووردت مشتقاتها في القرآن الكريم حوالي ستمائة وتسع وخمسين (659) مرّة، منها قام وأقام وقيام وقائم وقيُّوم وقِيَم وقَيِّم وقوام وتقويم، في حوالي مائة وستين (160) مرّة، واستقام ومستقيم في سبع وأربعين (47) مرّةً، وقيامة في سبعين (70) مرّة، وقَوْم في ثلاثمائة واثنتين وثمانين (382) مرّةً.
- فالله سبحانه حيٌّ قيُّوم، يقوم بذاته ويستغني عن غيره، ويسوس الأُمور ويسيطر عليها، فهي خاضعة له، (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) (طه/ 111)، وهو سبحانه: (قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ) (الرعد/ 33)، فهو بها عليمٌ، ولها حفيظٌ، وعليها رقيب.
- والدِّين القيّمُ الموصل إلى كلّ خير بلا انحراف أو زيغ، وما سواه أديانٌ غيرُ مستقيمة، (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ) (الروم/ 43).
- والصراط المستقيم: الواضح الموصل إلى هدفه وغايته دون عناء في الجهد، ودون ضلال في الطريق، (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) (هود/ 112)، (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة/ 6).
- والقرآن يهدي للتي هي أقومُ (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) (الإسراء/ 9)، من العقائد والشرائع والأخلاق، فمن اهتدى بهديه كان أقومَ الناس، والكُتُبُ القيِّمة هي الكُتُبُ التي يعدلُها ثمنٌ غال، ومكانةٌ رفيعة، وفائدةٌ كبيرة، وتجمعُ ما في غيرها من الخير.
- وقد خَلَقَ اللهُ الإنسانَ في أحسن تقويم (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (التين/ 4)، إذ اكتملت في خلقه صفات الحسن في التكوين الجسمي والعقلي والروحي، بما يتناسب والهدف من الخلق والوظيفة في الوجود.
- وكان بين ذلك قَواماً: توسطاً واعتدالاً ورشداً في الأمر بلا إفراط ولا تفريط، (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (الفرقان/ 67).
وهكذا فإنّ جماع المعاني اللغوية في أُصولها القرآنية تشير إلى أنّ الكون كلّه قائم على نظام تتقوّم به أشياؤه وظواهره، وأنّ حياة الإنسان في الكون تتقوّم بمنظومة من القيم تحدّد تصوّراته وعلاقاته وأعماله الظاهرة والباطنة. فكما أنّ الرؤية الكونية عند المسلم تتضمّن نظاماً في الاعتقاد ينشئ تصوّرات الإنسان وعباداته، ونظاماً في المعرفة ينشأ التشريعات والعلاقات، فكذلك تتضمّن هذه الرؤية نظاماً للقيم تتحدّد به دوافع السلوك والعمل.
نظام القيم + نظام المعرفة + نظام الاعتقاد = نظام الإسلام.
وإذا تأمّلنا في الدلالات المختلفة لمجمل الألفاظ القرآنية ذات العلاقة بجذر القيم، فإنّنا سنجدها تتركّز في أربعة مجالات من الدلالة، تتضافرُ وتتعاون في إعطاء الدلالة الكلّية للقيمة والقيم في الاصطلاح القرآني، وهذه المجالات الأربعة هي:
1- الوزن والفائدة والثمن والخيرية، فالأمرُ الذي لا قيمة له، لا وزن له ولا فائدة فيه، أمّا الأكثر قيمةً فهو الأفضل، والأكثر خيراً: (أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا) (الكهف/ 105).
2- الثباتُ والاستقرار والتماسك: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ) (الدخان/ 51).
3- المسؤولية والرعاية؛ فالقائم على الأمر مسؤولٌ عن رعايته وإدارة شؤونه: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) (النِّساء/ 34)، والله سبحانه هو: (اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (البقرة/ 255)، وهو سبحانه قائمٌ على كلّ نفس: (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ) (الرعد/ 33).
4- الاستقامة والصلاح: (وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) (الجن/ 16).
والقيم والأخلاق هي محدّدات وضوابط لسلوك الناس، تُميِّز النوع الإنساني عن غيره من المخلوقات، ولذلك فإنّها ترتبطُ بمتطلبات الاجتماع الإنساني والعيش المشترك، كما ترتبط بالكرامة الإنسانية. وتقع قضايا القيم في القلب ممّا شرّعت له الأديان والفلسفات المختلفة منذ بدء الحياة الإنسانية. ومن ثمّ فإنّ هذه القضايا ليست قضايا نسبية تترك الطريقة التي يتمُّ فيها فهمُها والتعامل معها للقناعات الشخصية، والتوجهات الإيديولوجية للفرد، وليست هي معايير يتمُّ تحديدها والتقنين لها بالأساليب الديمقراطية ليلتزم بها أفراد الجماعة، مع إبقاء الهامش الأكبر لما يمكن أن يعدّ ضمن الحرّيات الشخصية فحسب، وكذلك ليس من الحكمة أن ننفي عن قضايا القيم والأخلاق وجود منطلقات موضوعية عامّة يجمع عليها العقلاء من الناس لخصائص فيها في حدِّ ذاتها.
والقيمُ والأخلاق – في هذا السياق – لا تقتصر على ما كان معروفاً من قضايا الصدق والأمانة والوفاء وأمثالها من الفضائل العامّة، التي تتعلق بسلوك الفرد مع نفسه ومع الآخرين، وإنّما تشمل – بالإضافة إليها – فئاتٍ من القيم الخاصّة بالحياة المدنية؛ من مسؤولية اجتماعية، واحترام الآخرين، وقيم الولاء والانتماء العامّة في دوائره المختلفة على مستوى الشعب والأُمّة والإنسانية، كما تشمل القيم المهنية المتعلقة بالتعامل مع أشياء البيئة وحسن تنظيمها واستثمارها. وعلى هذا الأساس تعدّدت المجالات التي ظهرت فيها فئات القيم، فثمة قيمٌ للحكم والسياسة، وقيمٌ للأُسرة والمجتمع، وقيمٌ للإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد، وقيمٌ علمية «أكاديمية» في التعليم، وقيمٌ في التعامل مع البيئة، وقيمٌ إنسانية في التعامل مع الآخرين، وهكذا.
كثيرة هي المصطلحات القرآنية التي تتعلّق بالدلالة المعاصرة لمصطلح القيم، وأهمّيتها في الحكم على السلوك البشري، فإذا كانت الأخلاق وصفاً لسلوك الإنسان، فإنّ القيم معايير لتقويم هذا السلوك، فالإنسان يسلك سلوكاً أخلاقياً محدّداً؛ لأنّه يتبنّى قيماً محدّدة. ونحن نلاحظ أنّ المصطلحات القرآنية ذات العلاقة بالقيم تقع في مستويات مختلفة في العموم والخصوص؛ إذ يمكن تصنيف القيم في فئات حسب معايير متعدّدة:
- فالحقُّ، والعدلُ، والخيرُ، والإحسان، والتقوى هي قيمٌ عليا حاكمة رئيسية، بينما الحياء، والبرّ، والصبر، والعفو، والوفاء هي قيمٌ مشتقة فرعية.
- والعدلُ، والشورى، والحرّية، قيمٌ في البناء السياسي للأُمّة؛ والتكافل، والكرم، والصدقة، قيم في البناء الاجتماعي للأُمّة؛ بينما الشجاعة، والحلم، والصدق، هي قيمٌ في التزكية النفسية للأفراد.
- وقد يكون التصنيف على أساس التمييز بين قيم الأمر وقيم النهي.
- وقد يكون التصنيف على أساس القيم الواجبة والقيم المندوبة.
- وقد تكون «مقاصدُ الشرع» الخمسة نظاماً مناسباً لتصنيف القيم، تندرج تحت كلّ منها قيم فرعية منبثقة عنها.
- والإسلام هو «الدِّين القيِّم» و«دين القيِّمة»، وقد تكرر ذلك في القرآن الكريم ست مرّات، الأمر الذي يسوِّغ القول بأنّ دين الإسلام هو دين القيم الفاضلة، والثابتة. ومن ثمّ فإنّ نظام القيم في الإسلام هو نظام الإسلام بصورته الكلّية العامّة: عقيدة، وعبادة، وشريعة، وأخلاقاً.
- وهكذا...
لكن أي تصنيف للقيم لا يُلغي حقيقة التداخل والترابط بين المعاني والدلالات المختلفة للقيم والفضائل، بحسب زاوية النظر إلى فئات القيم أو إلى أيِّ قيمة مفردة، فقد ترتفع قيمة العدل لتصبح إطاراً لكلّ القيم الأُخرى، وقد ترتفع قيمةُ التقوى لتكون هي المستوى الأعلى. وإذا أخذنا «التوحيد» بوصفه قيمةً إسلامية، فسيكون – من غير شكّ – هو القيمة العليا.
المصدر: البلاغ
الزهور تبعد الكآبة
أكدت دراسة جديدة أنّ تلقي باقات الورود والأزهار المختلفة يعزز أحاسيس السعادة عند الإنسان وتقوِّي قدراته على التواصل الإجتماعي.
وأثبتت هذه الدراسة، التي سجلت شعور المرأة والرجل ممّن قدّمت لهم باقات الزهور، إنّ الأمل بإستمتاع الحياة قد إجتاح أحاسيسهم وكيانهم.. وتخلصوا من الإكتئاب الذي ينتابهم لبعض الوقت. وأكدت دراسة أخرى أجريت على أشخاص من الجنسين للبحث في التأثير النفسي الممكن حدوثه على تعزيز قدرة الإنسان على التواصل مع الآخرين بواسطة الورد.
إنّ عادة تقديم الزهور للآخرين من الظواهر الإيجابية، حيث ساعدت الورود في تحسين مزاج كل مَن تلقاها وسرت إلى نفوسهم مشاعر الغبطة والسعادة. ويرى الخبراء أنّه ليس بالضرورة أن ينتظر الإنسان أحداً ما ليقدم الورد له، بل يمكن تقديمه لنفسه لأنّ النتيجة في النهاية هي واحدة من حيث التأثير الإيجابي الجميل على النفس.
الأمل.. القوّة الكامنة
◄لن تجد لليأس ترياقاً كالأمل.. إنّه ليس للتسلية والسلوان، بل هو شعور داخلي يوحي بأنّ الحاضر لن يدوم. أصحاب الأمل ينظرون إلى المستقبل على أنّه "الفرصة القادمة" ويتعاملون معه وكأنّه تحت أطراف أصابعهم وترسمه أعمالهم وأفعالهم. فهم لا ينشغلون بالباب المغلق عن البحث عن أبواب أخرى تُفتح هنا وهناك.
إنّ خير الزهور لم نقطفها بعد.. إنّ خير البحور بحر لم تمخره سفننا بعد.. إنّ خير الأصدقاء صديق لم نتعرف عليه بعد.. إنّ خير الأيام يوم لم نعشه بعد.
أصحاب الآمال العريضة "يمتلكون القدرة على تحفيز أنفسهم والشعور بأنّهم واسعوا الحيلة بما يكفي للتوصل إلى تحقيق أهدافهم، مؤكدين لأنفسهم أنّ الأمور إذا ما تعرضت لمأزق ما، لابدّ أنّها سوف تتحسن". أما اليائسون فما إن تبزغ في أذهانهم فكرة مبدعة قفزوا بتفكيرهم نحو العقبات التي ستقف أمامهم، والصعوبات التي سيوجهونها، ومن ثم تخور قواهم وتستسلم وهم مازالوا في طور الفكرة.
لقد تواترت قصص كثيرة عن أولئك الذين أصيبوا بعاهة دائمة، أو نشئوا في ظروف مريعة، أو سجنوا لسنوات عديدة. لكنّهم امتلكوا ما عوّضهم عن كلّ شيء. إنّه الأمل الذي انطلقوا به وخطوا أغرب القصص وأبدعها.
لو سألتني: ما هو الشيء الذي بدونه أنت لا تملك شيئاً.. وإذا ملكته فلا تتحسر على أي شيء آخر؟ إنّه الأمل!
لا يوجد أسوأ من منظر شاب يائس..
بين دائرة الاهتمام ودائرة التأثير..
لو أرخيت سمعك بانتباه إلى ما يجول في مجالسنا من حديث هذه الأيام لرأيت إحدى أكثر صور اليأس وضوحاً، لقد امتلأت عقولنا وألسنتنا بالقصص المبكية على ما وصلت إليه أحوالنا خاصّة وأحوال المسلمين عامّة.
وعبر سنوات طويلة من ترديد هذه (النغمة) المحزنة تملكنا شعور عميق بأنّه ليس بالإمكان أبدع مما كان، وأنّه ما من سبيل لعمل شيء ذي قيمة سواءً في الشأن الشخصي أو ما يخص الأُمّة ككلّ، وأنّه ما من مخرج إلّا بمعجزة إلهية خارقة أو فاتح عظيم. وهذا شأن اليائسين في كلّ مكان وزمان. أما المتفاءلون الذين قدّموا للعالم خدماتهم الجليلة فيسلكون مسلكاً مختلفاً. يوضح ذلك الكاتب المميز ستيفن كوفي، حيث يفرّق بين كلا الفريقين بما يصرفون وقتهم وجهدهم بالتفكير والاهتمام به.
فاليائسون يملئون عقولهم وأوقاتهم بالتفكير بقضايا تقع في دائرة اهتمامهم، ولكنّها بعيدة عن دائرة تأثيرهم. فهي مهمة ولكن لايمكن عمل شيء تجاهها. ومثال ذلك الأسلحة النووية، والديون القومية، والاحتلال الأجنبي لبلد مجاور وغير ذلك.
أما المتفائلون فيصرفون أوقاتهم وأعمارهم فيما هو مهم وأساسي ويمكنهم أن يقوموا بشيء تجاهه، لأنّه يقع تحت تأثيرهم، وفي حدود إمكانياتهم. وتندرح تحت هذا البند عدد كبير من الأعمال ومنها قراءتك للكُتُب التي ترتقي بالذات، وإعداد نفسك لكي تكون قدوة في الالتزام والكفاءة في عملك، ومنها دعوتك لأهلك وجارك للحفاظ على الصلاة، وأداء المعروف، ونشر الفضيلة، واحترام القانون بين أبناء حيّك وغير ذلك. عندما تنشغل بهذه القضايا ستجد ثمرتها يانعة تفيض خيراً عليك وعلى الناس جميعاً وتترك أثراً لا ينمحي. وهل من علاج لليأس خير من هذا؟ ►
وزير الخارجية الايراني: لتثبت اميركا حسن نواياها عمليا للوصول الى الاتفاق في فيينا
اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان الاميركيين يدعون بانهم يرغبون بحل القضايا والوصول الى الاتفاق في مفاوضات فيينا ولكن عليهم ان يثبتوا عمليا حسن نواياهم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني حسن امير عبداللهيان الاربعاء مع الرئيس السوري بشار الاسد حيث تباحث الجانبان حول التعاون الثنائي والتطورات الاقليمية والدولية.
وهنأ امير عبداللهيان لنجاحات سوريا في الاصعدة السياسية والميدانية، مؤكدا على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للحكومة والشعب السوري.
واشار الى ان فصلا جديدا من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قد بدأ واضاف: ان التعاون الاقتصادي بين ايران وسوريا مدرج بصورة جادة في جدول اعمال العلاقات بين البلدين وان تسهيل النقل والترانزيت بين البلدين يحظى بالاهتمام وفي هذا السياق فان التعامل والعلاقات الشعبية يكتسب الاهمية ايضا.
ورحب امير عبداللهيان بتطبيع العلاقات بين دول المنطقة وسوريا واشار الى الاشتراك في المواقف بين البلدين في الكثير من القضايا والمواضيع الاقليمية والدولية واضاف: انه وفيما يتعلق بالتوترات الاقليمية تعارض الجمهورية الاسلامية الايرانية اي حرب وتدعو الى حل وتسوية الخلافات عن طريق الحوار والسبل السلمية السياسية. وفي هذا السياق تدعو ايران لحل وتسوية ازمة اليمن عن طريق الحوار اليمني-اليمني وترى بان تغيير سلوك بعض دول المنطقة يمكنه المساعدة في الوصول الى حل لهذه الازمة.
وحول تطورات قضية اوكرانيا قال: نحن نعارض الحرب ونعارض الحظر. طريق الحل لازمة اوكرانيا هو الحل السياسي.
وبشان مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" قال امير عبداللهيان: لقد اقتربنا من الاتفاق في مفاوضات فيينا. ورغم ان الاميركيين يدعون بانهم يرغبون بحل القضايا والوصول الى الاتفاق ولكن عليهم ايضا ان يثبتوا عمليا حسن نواياهم.
من جانبه أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء صوابية المسار الذي تسلكه إيران في هذا الإطار عبر تمسكها بالمبادئ والحقوق وعدم التنازل أمام ما تتعرض له من ضغوط، معتبراً أنه في السياسة لا توجد نوايا بل معايير ومبادئ.
وقال: أن التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني أصبح اليوم أكثر أهمية لخدمة مصالح إيران والمنطقة وللتوازن العالمي.
واعتبر الرئيس الاسد زيارة مجموعة من علماء اهل السنة في ايران لسوريا بانه يكتسب معنى مهما.
وحمل الرئيس السوري، وزير الخارجية الايراني تحياته الحارة لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي ورئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي.
وجرى البحث خلال اللقاء حول تطورات القضية الفلسطينية وسائر القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.
لماذا يكره طفلك الرياضيات؟.. إليك الأسباب والحل
طريقة التدريس المملة للرياضيات تعد سببا رئيسيا وراء كراهيتها.
أكبر عقبة في عملية تعلم الرياضيات هي الافتقار إلى الممارسة (غيتي)
ليلى علي
الرياضيات هي أساس الحياة وبدونها لا يستطيع العالم أن يتحرك شبرا واحدا. يحتاج كل شخص إلى الرياضيات في حياته اليومية، سواء كان طباخا أو مزارعا أو نجارا أو ميكانيكيا أو صاحب متجر أو طبيبا أو مهندسا أو عالما أو موسيقيا.
حتى الحشرات تستخدم الرياضيات في حياتها اليومية من أجل الوجود. تصنع القواقع أصدافها، والعناكب تصمم شبكاتها، ويبني النحل أمشاطا سداسية. هناك أمثلة لا حصر لها من الأنماط الرياضية في نسيج الطبيعة. يمكن لأي شخص أن يكون عالم رياضيات إذا تم إعطاؤه التوجيه والتدريب المناسبين في الفترة التكوينية من حياته.
وبالرغم من كل ذلك تتمتع الرياضيات بسمعة واسعة لكونها المادة التي يكرهها الطلاب. ومن المألوف سماع عبارة "أنا أكره الرياضيات" أو "الرياضيات صعبة للغاية"، ولكن ما الأسباب الشائعة التي تجعل الكثير من الطلاب يكرهون الرياضيات؟
إن تعلم الرياضيات يمكن أن يكون سهلا وماتعا إذا كان المنهج يتضمن أنشطة وألعابا رياضية (بيكسلز)
عدم معرفة الأساسيات
وفقا لمدونة "سكوول ليسنز" (Schoolessons)، يعد هذا هو السبب الأول لكراهية الأطفال للرياضيات. وبدون تعلم الأساسيات جيدا للطلاب في الفصول الدراسية الأولى لا يمكنهم فهم دروس الرياضيات في الفصول المتقدمة. فقد تم تصميم منهج الرياضيات بطريقة تجعل الأطفال يواجهون مشاكل رياضية أكثر تعقيدا أثناء وصولهم إلى فصول دراسية أعلى والتي لا يمكن القيام بها دون معرفة الأساسيات.
لا توجد قصص في الرياضيات
طريقة التدريس المملة للرياضيات تعد سببا آخر وراء كراهيتها. في العلوم والمواد الأخرى، يمكن تدريس الموضوعات بطريقة سرد القصص التي تخلق مساحة للطفل للدخول في الموضوع بتخيلاته وأحلامه مما يجعل الموضوع أكثر تشويقا حتى يفهمه الطفل. ولكن في حال الرياضيات، لا توجد قصص يمكن للمدرسين مشاركتها مع الطلاب، فهناك فقط بعض الصيغ والنظريات والإجراءات الرياضية الأكثر تعقيدا.
مشكلة الذاكرة
يعاني معظم الطلاب من مشاكل في الذاكرة تؤثر على دراستهم. لكن الرياضيات بشكل أساسي تعتمد على تذكر المعادلات والنظريات والرسوم البيانية وحساب التفاضل والتكامل واللوغاريتمات والمتواليات وغيرها الكثير التي يصعب على الأطفال حفظها.
مشكلة أخرى تكمن في طريقة الحل، حيث يمكن أن تكون هناك طرق مختلفة للوصول إلى نفس النتيجة، لكن الطفل بحاجة إلى تذكر الطريقة التي يريدها المعلم في الفصل للحصول على العلامات الكاملة. يجب كتابة كل خطوة متضمنة في حل المشكلة كما يريد المعلم.
يكره بعض الطلاب الرياضيات لأنهم يعتقدون أنها مملة (غيتي)
طرق محدودة لكسب العلامات
وفقا لما جاء في موقع "أكسفورد ليرنينغ" (Oxford learning)، فإنه في موضوعات مثل اللغة الإنجليزية أو الكتابة، يمكن أن يحصل الطالب على العلامات من مجموعة متنوعة من العوامل مثل الإبداع والتهجئة والقواعد والأسلوب وعلامات الترقيم وغيرها. أما في الرياضيات، هناك فرص قليلة لكسب العلامات لأن الإجابة يمكن أن تكون إما صحيحة أو خاطئة فقط.
الاعتقاد بأن الرياضيات مادة مملة
يكره بعض الطلاب الرياضيات لأنهم يعتقدون أنها مملة. فهم لا يهتمون بالأرقام والصيغ بالطريقة التي يتحمسون بها للتاريخ أو العلوم أو اللغات أو الموضوعات الأخرى التي يسهل التفاعل معها شخصيا. يرون الرياضيات كأرقام مجردة وغير ذات صلة يصعب فهمها.
سهولة ارتكاب الأخطاء
يتطلب تعلم الرياضيات ارتكاب الكثير من الأخطاء. يجب على الطلاب تكرار نفس أنواع الأسئلة مرارا وتكرارا حتى يحصلوا على الإجابات الصحيحة، وقد يكون الأمر محبطا في حال تكرر الحصول على إجابات خاطئة، يمكن لذلك أن يؤثر سلبا على ثقة الفرد، مما يدفعه إلى الابتعاد عن الموضوع.
أكبر عقبة في تعلم الرياضيات
أكبر عقبة في عملية تعلم الرياضيات هي الافتقار إلى الممارسة. يجب أن يعمل الطلاب يوميا على حل 10 مشاكل على الأقل من مناطق مختلفة من أجل إتقان المفهوم وتطوير السرعة والدقة في حل مشكلة ما. يجب كذلك تشجيع الطلاب في سن صغيرة على تعلم جداول الضرب.
يعاني معظم الطلاب من مشاكل في الذاكرة تؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي (غيتي)
التعلم من الأخطاء
ارتكاب الأخطاء جزء من التعلم، إذا شعر طفلك بالإحباط أثناء تعلم الرياضيات، ذكريه أن ارتكاب الأخطاء هو مجرد جزء من عملية التعلم. من المهم ألا يتجنب المهام التي تنطوي على تحديات وتتطلب عملا شاقا. ساعدي طفلك على فهم أنه كلما كان من الصعب الحصول على إجابة صحيحة؛ كان ذلك أكثر إمتاعا عندما يحلها في النهاية.
والرياضيات جزء من الحياة، أظهري لطفلك كيف ترتبط الرياضيات بسيناريوهات العالم الحقيقي من أجل إثارة اهتمامه بالموضوع. إذا كان لديك أي أقارب أو أصدقاء يعملون مع الأرقام خلال عملهم، فاطلبي منهم التحدث إلى طفلك حول وظيفتهم في المرة القادمة التي يرونه فيها.
واستخدمي ألعاب تحفيز ذهنية، في أوقات فراغ طفلك، قدمي له ألعاب تحفيز ذهنية قائمة على الأرقام تركز على بناء مهارات حل المشكلات بدلا من الحفظ. يمكن أن تكون هذه طريقة ماتعة لإثارة اهتمام طفلك بالرياضيات.
كيف يتجنب طفلك رهاب الرياضيات في المدرسة؟
وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" (TimesOfIndia)، فإن تعلم الرياضيات يمكن أن يكون سهلا وماتعا إذا كان المنهج يتضمن أنشطة وألعابا رياضية. تشجع الألغاز في الرياضيات الطفلَ، وتجذب موقفا منفتحا بين الشباب وتساعدهم على تطوير الوضوح في تفكيرهم.
يجب التركيز على تطوير مفهوم واضح في الرياضيات لدى الطفل، مباشرة منذ الصفوف الابتدائية. إذا فشل المعلم في ذلك، سيطور الطفل رهابا للرياضيات أثناء انتقاله إلى الفصول العليا. لشرح موضوع في الرياضيات، يجب على المعلم أن يساعد بالصور والرسومات والمخططات والنماذج قدر الإمكان.
متى تكتمل عملية التعلم؟
يُعتقد أن عملية التعلم تكتمل إذا كانت حاسة السمع لدينا مصحوبة بإحساسنا بالبصر. يجب عرض أسئلة مفتوحة على الطفل للإجابة عنها ويجب تشجيعه على التفكير في الحلول بكل الطرق الممكنة. ويجب تقدير الطفل لكل محاولة صحيحةـ ويجب تصحيح الأخطاء فورا من دون أي انتقاد.
العصر الحالي هو عصر تنمية المهارات والابتكارات. كلما كنا أكثر معرفة وتعاملا بالرياضيات في نهجنا، سنكون أكثر نجاحا. إنها أداة في أيدينا لجعل حياتنا أبسط وأسهل.
المصدر : مواقع إلكترونية
قائد الثورة: خدمات المرحوم ريشهري مصدر خير للجمهورية الاسلامية
أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ، ان خدمات المرحوم حجة الاسلام محمدي ريشهري كانت مصدر خير لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ادى قائد الثورة الإسلامية ، مساء يوم الاربعاء صلاة الجنازة على جثمان الراحل حجة الإسلام والمسلمين ريشهري، ثم ألقى كلمة قصيرة أمام ذوي الفقيد والمقربين منه، واصفا خدمات المرحوم بانها كانت مصدر ر خير لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.
كما اشار آية الله الخامنئي إلى لقائه الأول مع المرحوم ريشهري، وكذلك اجتماعات العمل ، بما في ذلك أثناء تصديره لوزارة الامن، وقال: لقد استمتعت حقًا بلقائه والتحدث معه، لأنه كان حريصا ويحمل قيم معنوية في الدرب وفي العمل.
أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بيانا عزى فيه بوفاة حجة الاسلام محمدي ري شهري مثنيا على الجهاد المستمر لهذا العالم الثوري وتقواه ونقاء نفسه معتبرا رحيله خسارة مريرة تثير الأحزان.
تجدر الاشارة الى سماحة قائد الثورة اشار في البيان الذي أصدره الى تواجد هذا العالم الرباني ورجل العلم والاخلاق والثورة والسياسة والادارة في مختلف سوح الجهاد ما صنع منه شخصية قل نظيرها، قائلا "انني وخلال عشرات السنوات من معرفتي به شهدت منه دوما الصلاح والتقوى، وآمل ان تؤدي هذه الباقيات القيمة الى نيل موجبات الرحمة والمغفرة الالهية وعلو الدرجات".
ولبى حجة الاسلام محمدي ري شهري سادن روضة السيد عبدالعظيم الحسني عليه السلام أمس الاول الثلاثاء، نداء ربه عن عمر يناهز 75 عاما.
ولد هذا العالم الرباني في طهران عام 1946 وذهب إلى حوزة قم للدراسة عام 1961 وتتلمذ عند علماء كبار مثل آية الله كلبايكاني ووحيد خراساني والحائري وجواد تبريزي وغيرهم.
وكان حجة الاسلام ري شهري في طليعة المجاهدين خلال سنوات الثورة ، وبعد الثورة شغل مناصب كعضو في مجلس خبراء القيادة ، ووزارة الامن ، والنائب العام للبلاد، وبعض المسؤوليات الأخرى ، بما في ذلك إنشاء وإدارة جامعة القرآن والحديث.
وتعرض هذا العالم المجاهد الى الاعتقال والمحاكمة واودع السجن في زمن النظام السابق عدة مرات بسبب نضاله وخطاباته المعادية للنظام البائد وكان له دور بارز في دعوة الجماهير الى النضال والثورة .
وكان الفقيد الراحل ايضا من اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام كما عينه قائد الثورة الاسلامية في منصب ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة ورئيس بعثة الحج الايرانية ايضا.
ولهذا العالم الراحل العديد من الكتب والمؤلفات في العلوم الاسلامية والانسانية والتاريخ.
موقف العقل من القرآن الكريم
د. عمرو شريف
◄مما يلفت الانتباه أن لفظ "العقل" في صيغته الاسمية لم يرد في القرآن الكريم مطلقاً، لكن وردت مشتقاته في صِيغَّه الفعلية، مثل عقلوا ويعقلون وتعقلون ونعقل ويعقل، قرابة خمسين مرة. أما الألفاظ التي تدل على النشاط العقلي بصفة عامة، مثل التفكير والتدبر والعلم والنظر والإدراك والتفكر والتبصر، فقد وردت مئات المرات.
وربما يرجع عزوف القرآن الكريم عن استخدام الصيغ الاسمية إلى اهتمامه بالأفعال ونتائجها أكثر من اهتمامه بالتفاصيل النظرية. كذلك فإن استخدام الصيغة الاسمية يتطلب وضع تعريفاً للعقل، بينما كثيراً ما تفشل التعريفات في تصوير الشيء المُعرَّف تصويراً دقيقاً، لاسيّما إذا اتصل هذا الشيء بحقائق روحية أو نفسية، حتى قالوا "يكمن الشيطان في التعريفات، كما يكمن في التفاصيل". كما يتطلب استخدام الصيغة الاسمية المُعرَّفة تحديد الموضع والعضو الذي يقوم بتلك المهمة، ويبدو من تناول القرآن الكريم – وأيضاً كما أثبت العلم – أنّ هذه قضية شديدة التعقيد.
ومن أجل أن نستخلص موقف القرآن الكريم من العقل، نعرض ثلاثة نماذج من الآيات تدعونا إلى استخدام العقل وإلى التأمل، نحسب أنها كافية لعرض تصورنا عن "موقف القرآن الكريم من العقل" والذي استخلصناه من تأمل جميع الآيات التي ورد فيها ما يدل على العقل:
أ) في تأمل الظواهر الكونية يقول تعالى:
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (البقرة/ 164).
(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَفِي الأرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (الرّعد/ 3-4).
ب) في تأمل الأنفس البشرية يقول تعالى:
(وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) (الذاريات/ 20-21).
(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ) (الرّوم/ 8).
(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (فصّلت/ 53).
ج) وفي تأمل الظواهر الاجتماعية يقول تعالى:
(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) (البقرة/ 44).
(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (الرّوم/ 28).
يمكن من تأمل هذه الآيات الكريمة – وغيرها – أن نستخلص عدة ملاحظات حول موقف القرآن الكريم من العقل، أهمها:
أوّلاً: الثقة التي يوليها القرآن الكريم للحواس، بحيث تكون معطياتها دائماً هي منطلق التفكر والتدبر للاستدلال على الصانع المنعم. وهذا يدل كذلك على وثاقة الارتباط بين كلٍ من الحواس والعقل.
ثانياً: الوضوح والبساطة فيما تأمر به الآيات من عمليات التفكير والتدبر والتعقل، كأنّها أمور لا تحتاج إلى تفكير عميق، أو بحث غامض، أو تحليل معقد (كمنهج الفلسفة والمنطق علم الكلام)، وإنما هي تُدرَك إدراكاً مباشراً أشبه ما يكون بالبهديهيات العقلية.
ثالثاً: يمثل العقل ميزة فريدة وضعها الله – عزّ وجلّ – في الإنسان؛ به يَعرف ثمّ يعمل، ومن هنا كانت مسؤولياته.
رابعاً: أنّ العقل الذي يتحدث عنه القرآن الكريم ليس عقلاً مجرداً، أو جوهراً قائماً بذاته (كما يعتقد الفلاسفة)، وإنما هو ظاهرة أو طاقة أو مَلَكة تمثل قدرة إلهية في الإنسان، زوده الله تعالى بها ليستعملها في حدودٍ رسمها له ونبهه إليها. وبها يصبح العقل الإنساني – في القرآن الكريم – عقلاً واعياً بطاعة الله عزّ وجلّ، فيأتمر عن طواعية بما أمر الله تعالى به.
خامساً: إنّ العقل البشري لا يصلح أن يكون حَكَماً في كلّ شيء، ويتوجه هذا الحَجْر إلى بضعة أمور:
1- أمور لا يدركها العقل الإنساني، كالذات الإلهية، فليس مما يعرفه العقل شيء يماثلها، حتى يمكن أن يقيسها عليه.
2- أمور لا تدخل في حدود الطبيعة البشرية المحددة، كحقيقة الروح.
3- أمور لا تلزم للنهوض بوظيفة الإنسان في الوجود؛ كالغيب المحجوب عن العلم البشري، ومثاله موعد يوم القيامة.
ويبين الحق سبحانه كيف ينبغي تلقِّي مثل هذه الأمور، التي هي فوق مدركات البشر:
(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ * رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (آل عمران/ 7-8).
وفيما عدا هذه الجوانب، فإنّ العقل البشري مدعو للتدبر والتفكر والاعتبار، والتطبيق في عالم الضمير وعالم الواقع في إطار منهج الإسلام. وما من دين – أو منهج وضعي – احتفل بإيقاظ الإدراك البشري، وإطلاقه من قيود الوهم والخرافة، وصيانته في الوقت ذاته من التبدد، كما فعل الإسلام.
سادساً: إنّ العقل ينبغي أن يتحرك من أجل ثلاث غايات متداخلة متلازمة؛ غاية إيمانية، وغاية معرفية، وغاية سلوكية حياتية. ومجال حركته ثلاثة جوانب متداخلة: الظواهر الكونية – الأنفس – الظواهر الاجتماعية.
إنّ المنهج الذي يرسمه القرآن للعقل للنظر والتدبر، هو الانتقال من الجزئيات إلى الكليات، أو تحليل الكليات إلى جزئياتها ثمّ الانتقال من ذلك إلى التركيب (الخروج بمفاهيم جديدة)، أو أي طريقة أخرى يكتشفها العقل لنفسه دونما قيد عليه أو حَجْر. وبهذا المعنى فإنّ القرآن الكريم يحفز العقل البشري إلى النظر في الآفاق والأنفس والمجتمعات بأي منهج علمي، مهما تعددت المناهج ومهما تَسَمَّت العلوم بأسماء متشابهة أو متباينة.
سابعاً: يقرر القرآن الكريم ان من يعطل طاقة العقل الممنوحة له ينزل إلى مرتبة دون مرتبة الحيوان.
(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) (الأنفال/ 22).
كما يقرر القرآن أن جزاء معطل العقل هو السعير.
(وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ* فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأصْحَابِ السَّعِيرِ) (الملك/ 10-11).
ثامناً: لم يكتف القرآن الكريم بحَثِّ العقل على العمل وترك التقليد والجحود، لكنه أثار أمامه عدداً من المسائل والقضايا الحيوية، وعالجها كنماذج لما ينبغي أن يكون عليه أداء العقل للقيام بالرسالة المنوطة به. وأهم هذه القضايا بالطبع قضية الاستدلال على خالق الكون دون وقوع في المحظور؛ الذي هو البحث في كنه الله وفيما اختص به نفسه. ومن هذه القضايا أيضاً الخلافات الجوهرية مع أرباب الملل والنحل الأخرى، كدعوى ألوهية عيسى (ع).
تاسعاً: ربما كانت أقرب الآيات إشارة لموضع عملية التعقل هي قول الحق – عزّ وجلّ –: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (الحج/ 46)، وتشير الآية إلى أن للقلب دوراً في عملية التعقل. ولنا في هذه الآية تأويلان؛ إما أنها لا تقصد العضلة الكائنة في الجانب الأيسر من تجويف الصدر والتي تضخ الدم لأجزاء الجسم، بل تشير إلى "الجوهر" المدرك المتعقل في الإنسان، وأنّ الآية قد استخدمت كلمة قلب لوصف هذا الجوهر. ون أنّ الآية تشير إلى العضو التشريحي المسمى بالقلب، وفي هذه الحالة لا تتعارض الآية مع معارفنا العلمية، إذ إنّ الشواهد العلمية الحديثة تتجمع منذ قرابة ثلاثة عقود على أنّ لهذا القلب دوراً في المنظومة المعرفية والشعورية للإنسان.
وبعد هذا العرض لموقف القرآن الكريم من العقل، هل لي أن أتساءل: أمن سوء الفهم أو من سوء القصد أن يُرمَى القرآن الكريم بأنّه مُعَوِّق للفكر مقيد لحريته، أو القول بأنّ النظر العقلي عند العرب كان محاولة لتكميل القرآن في الجانب الذي قَصَّرَ فيه؟! لا شك أن تلك دعاوي باطلة.►
المصدر: كتاب ثمّ صارَ المخُّ عقلاً
لماذا لم يظهر الإمام المهدي (عج) إلى الآن؟
لماذا لم يظهر الإمام المهدي (عج) إلى الآن؟ وإذا كان قد أَعَدَّ نفسه للعمل الاجتماعيّ، فما الذي منعه عن الظهور على المسرح في فترة الغيبة الصغرى أو في أعقابها، بدلًا عن تحويلها إلى غيبةٍ كبرى، حيث كانت ظروف العمل الاجتماعيّ والتغييريّ، وقتئذٍ، أبسط وأيسر، وكانت صِلتُه الفعليّة بالناس، من خلال تنظيمات الغيبة الصغرى، تتيح له أن يجمع صفوفه ويبدأ عمله بدايةً قويّةً، ولم تكن القوى الحاكمة من حوله قد بلغت الدرجة الهائلة من القدرة والقوّة التي بلغتها الإنسانيّة بعد ذلك، من خلال التطوّر العلميّ والصناعيّ؟
الظروف الموضوعيّة، وأثرها في عمليّات التغيير الاجتماعيّ
والجواب، إنّ كلّ عمليّة تغييرٍ اجتماعيٍّ يرتبط نجاحها بشروطٍ وظروفٍ موضوعيّةٍ لا يتأتّى لها أن تُحقِّق هدفها، إلّا عندما تتوفّر تلك الشروط والظروف. وتتميّز عمليّات التغيير الاجتماعيّ، التي تفجّرها السماء على الأرض، بأنّها لا ترتبط، في جانبها الرساليّ، بالظروف الموضوعيّة؛ لأنّ الرسالة التي تعتمدها عمليّة التغيير هنا، ربانيّةٌ ومن صنع السماء، لا من صنع الظروف الموضوعيّة، ويرتبط نجاحها وتوقيتها بتلك الظروف.
ومن أجل ذلك، انتظرت السماءُ مرور خمسة قرونٍ من الجاهليّة، حتّى أنزلت آخر رسالاتها، على يد النبيّ محمّدٍ (صلى الله عليه وآله)؛ لأنّ الارتباط بالظروف الموضوعيّة للتنفيذ، كان يفرض تأخّرها، على الرغم من حاجة العالَم إليها منذ فترةٍ طويلةٍ قبل ذلك.
والظروف الموضوعيّة، التي لها أثرٌ في الجانب التنفيذيّ من عمليّة التغيير، منها ما يشكّل المناخ المناسب والجوّ العامّ للتغيير المستهدف، ومنها ما يشكّل بعض التفاصيل التي تتطلّبها حركة التغيير، من خلال منعطفاتها التفصيليّة.
فبالنسبة إلى عمليّة التغيير التي قادها -مثلًا- لينين في روسيا بنجاحٍ، كانت ترتبط بعاملٍ من قبيل قيام الحرب العالَميّة الأولى، وتَضَعْضُعِ القيصريّة، وهذا ما يساهم في إيجاد المناخ المناسب لعمليّة التغيير، وكانت ترتبط بعوامل أخرى جزئيّةٍ ومحدودةٍ، من قبيل سلامة لينين -مثلًا- في سفره الذي تسلّل فيه إلى داخل روسيا، وقاد الثورة؛ إذ لو كان قد اتّفق له أيُّ حادثٍ يعيقه، لكان من المحتمل أن تفقد الثورةُ، بذلك، قدرتَها على الظهور السريع على المسرح.
وقد جرت سنّة الله -تعالى- التي لا تجد لها تحويلًا، في عمليّات التغيير الربّانيّ، على التقيّد، من الناحية التنفيذيّة، بالظروف الموضوعيّة، التي تحقّق المناخ المناسب والجوّ العامّ لإنجاح عمليّة التغيير. ومن هنا، لم يأتِ الإسلام إلّا بعد فترةٍ من الرُسل، وإفراغٍ مريرٍ استمرّ قرونًا من الزمن.
فعلى الرغم من قدرة الله -سبحانه وتعالى- على تذليل العقبات والصعاب كلّها في وجه الرسالة الربّانيّة، وخلق المناخ المناسب لها خلقًا بالإعجاز، لم يشأ أن يستعمل هذا الأسلوب؛ لأنّ الامتحان والابتلاء والمعاناة التي من خلالها يتكامل الإنسان، يفرض على العمل التغييري الربّانيّ أن يكون طبيعيًّا وموضوعيًّا من هذه الناحية. وهذا لا يمنع من تدخّل الله -سبحانه وتعالى-، أحيانًا، فيما يخصّ بعض التفاصيل التي لا تكوِّن المناخ المناسب، وإنّما قد يتطلّبها، أحيانًا، التحرّك ضمن ذلك المناخ المناسب. ومن ذلك، الإمداداتُ والعناياتُ الغيبيّةُ التي يمنحها الله -تعالى- لأوليائه في لحظاتٍ حرجةٍ، فيحمي بها الرسالة؛ وإذا بنار نمرودٍ تصبح بَردًا وسلامًا على إبراهيم، وإذا بيد اليهوديّ الغادِر التي ارتفعت بالسيف على رأس النبيّ (صلى الله عليه وآله) تُشَلّ وتفقد قدرتها على الحركة، وإذا بعاصفةٍ قويّةٍ تجتاح مخيّمات الكفّار والمشركين، الذين أحدقوا بالمدينة في يوم الخندق، وتبعث في نفوسهم الرعب. إلّا إنّ هذا كلّه لا يعدو التفاصيل وتقديم العون في لحظاتٍ حاسمةٍ، بعد أن كان الجوّ المناسب والمناخ الملائم لعمليّة التغيير، على العموم، قد تكوّن بالصورة الطبيعيّة، ووفقًا للظروف الموضوعيّة.
موقف الإمام المهديّ (عج) من الظروف الموضوعيّة
وعلى هذا الضوء، ندرس موقف الإمام المهديّ (عج)، لنجد أنّ عمليّة التغيير، التي أُعِدَّ لها، ترتبط من الناحية التنفيذيّة -كأيّ عمليّةِ تغييرٍ اجتماعيٍّ أخرى- بظروفٍ موضوعيّةٍ تساهم في توفير المناخ الملائم لها. ومن هنا، كان من الطبيعيّ أن تُوَقَّت وفقًا لذلك.
ومن المعلوم أنّ المهديّ لم يكن قد أعدّ نفسه لعملٍ اجتماعيٍّ محدودٍ، ولا لعمليّةِ تغييرٍ تقتصر على هذا الجزء من العالَم أو ذاك؛ لأنّ رسالته، التي ادُّخِر لها من قِبَلِ الله -سبحانه وتعالى-، هي تغييرُ العالَم تغييرًا شاملًا، وإخراج البشريّة، كلّ البشريّة، من ظلمات الجور إلى نور العدل. وعمليّة التغيير الكبرى هذه لا يكفي في ممارستها مجرّد وصول الرسالة والقائد الصالح، وإلّا لتمّت شروطُها في عصر النبوّة بالذات، وإنّما تتطلّب مناخًا عالَميًّا مناسِبًا، وجوًّا عامًّا مساعِدًا، يحقّق الظروف الموضوعيّة المطلوبة لعمليّة التغيير العالَميّة.
فمن الناحية البشريّة، يُعتبَر شعور إنسان الحضارة بالنفاد عاملًا أساسيًّا في خلق ذلك المناخ المناسب لتقبّل رسالة العدل الجديدة، وهذا الشعور بالنفاد يتكوّن ويترسّخ من خلال التجارب الحضاريّة المتنوّعة، التي يخرج منها إنسان الحضارة مثقلًا بسلبيّاتِ ما بنى، مُدرِكًا حاجته إلى العون، متلفّتًا بفطرته إلى الغيب أو إلى المجهول.
ومن الناحية المادّيّة، يمكن أن تكون شروط الحياة المادّيّة الحديثة أقدر من شروط الحياة القديمة، في عصرٍ كعصر الغيبة الصغرى، على إنجاز الرسالة على صعيد العالَم كلّه، وذلك بما تحقّقه من تقريبِ المسافات، والقدرة الكبيرة على التفاعل بين شعوب الأرض، وتوفير الأدوات والوسائل التي يحتاجها جهازٌ مركزيٌّ لممارسة توعيةٍ لشعوب العالَم، وتثقيفها على أساس الرسالة الجديدة.
وأمّا ما أُشيرَ إليه في السؤال، من تنامي القوى والإرادة العسكريّة التي يواجهها القائد في اليوم الموعود كلّما أجَّل ظهوره، فهذا صحيحٌ. ولكن، ماذا ينفع نموّ الشكل المادّيّ للقوّة، مع الهزيمة النفسيّة من الداخل، وانهيار البناء الروحيّ للإنسان الذي يملك تلك القوى والأدوات كلّها؟ وكم من مرّةٍ، في التاريخ، انهار بناءٌ حضاريٌّ شامخٌ بأوّل لمسةٍ غازِيَةٍ؛ لأنّه كان منهارًا قبل ذلك، وفاقدًا الثقةَ بوجوده، والقناعةَ بكيانه، والاطمئنانَ إلى واقعه؟
الإمام المهديّ وبناء المجتمع الإلهيّ، دار المعارف الإسلاميّة الثقافيّة
16-03-2022