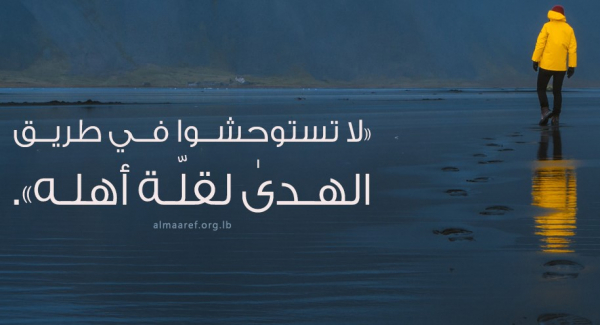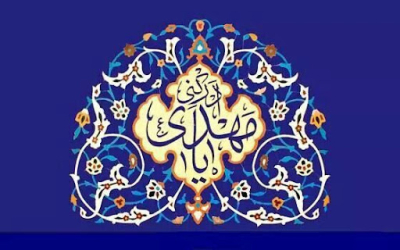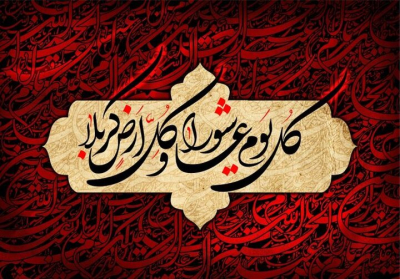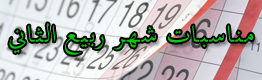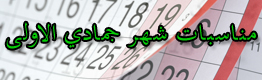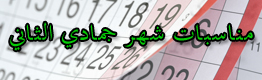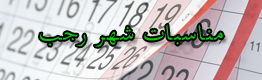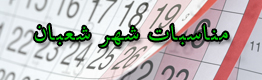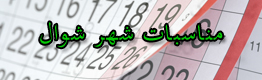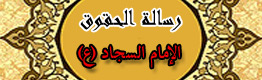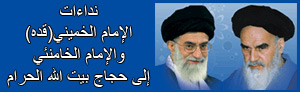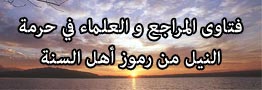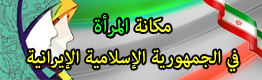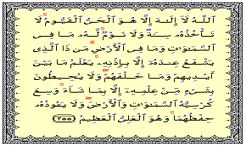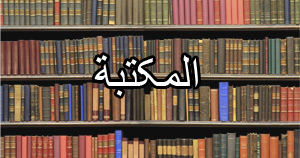emamian
أصحاب الصراط ومشقّة الطريق
إنّ السير علىٰ الصراط المستقيم صعب وشاقّ للغاية، لأنّ رفاق هذا الطريق وإن كانوا من العظماء ولكنّهم قليلون، ويجب المضي علىٰ هذا الطريق الطويل مع قلّة الرفيق. ولذلك فإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) الّذي هو بنفسه صراط مستقيم يقول: «لا تستوحشوا في طريق الهدىٰ لقلّة أهله».[1] إذن فالصراط المستقيم ليس مليئاً بالسالكين، ولهذا فإنّ المضي علىٰ الصراط يحتاج إلىٰ سعيٍ حثيث وزمن طويل حتّىٰ يتمكّن الإنسان أن يبلغ درجة الوليّ ويدخل في جمع أولياء الله تعالىٰ.
والدليل الآخر علىٰ قلّة الرفاق في سلوك الصراط هو انّ القرآن الكريم في الآية محلّ البحث علىٰ الرغم من ذكره (المنعم عليهم) و(المغضوب عليهم) و(الضالّين) بلفظ الجمع، لكنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قسَّم الناس في حديث له إلىٰ ثلاثة أقسام وذكر قسماً واحداً منها فقط بلفظ الجمع فقال: «الناس ثلاثة: فعالم ربّاني ومتعلّم علىٰ سبيل نجاة وهمج رِعاع أتباع كلّ ناعق يميلون مع كلِّ ريح»[2] ففي هذا الحديث ذكر العالم الربّاني والمتعلّم علىٰ سبيل النجاة بصيغة المفرد لقلّتهما، وأمّا المحرومون من الإرادة والّذين هم ليسوا من العلماء ولا من المتعلّمين فقد ذكروا بلفظ الجمع.
والشاهد الآخر علىٰ قلّة الأصحاب في سفر الصراط المستقيم انّ الله سبحانه يقول حول جهنّم: ﴿لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين﴾[3] ولم يقل حول الجنّة انّه سيملؤها، لأنّ الّذين يملؤون جهنّم كثيرون ولكنّ الّذين مأويٰهم الجنّة فهم قليلون.
وعليه فانّ طريق الهداية بسبب قلّة سالكيه موحش ومحفوف بالأخطار، ولذلك يوصي أمير المؤمنين أن لايستوحشوا من قلّة سالكي طريق الحقّ، فإنّ ذلك لايدعوا إلىٰ القلق لأنّ السالكين مع قلّتهم إلاّ أنّهم جميعاً من المحسنين.
آية الله الشيخ جوادي آملي
[1] . نهج البلاغة، الخطبة 201، المقطع 1.
[2] . نفس المصدر، الحكمة 147.
[3] . سورة السجدة، الآية 13.
هل يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية السعودية؟ (مقال تحليلي)
إسطنبول/ يوسف بهادر كسكين
- النهج الذي اتبعته الرياض وخاصة بعد 2015، تخطى المساعي العقلانية، ووصل في بعض الأحيان إلى حد الاستعداء
- لن يكون هناك مستفيد من التوتر على المدى الطويل، وإعادة تأسيس التعاون بين البلدين ستنعكس بالفائدة على الطرفين والمنطقة
- الحركات الشعبية التي اندلعت أواخر 2010 وسميّت بـ "الربيع العربي" شكلت نقطة انكسار في العلاقات التركية السعودية
- كانت الرياض من أهم مؤيدي السيسي الذي استولى على السلطة بانقلاب أطاح بمرسي؛ ومع ذلك استطاعت تركيا والسعودية المضي قدما بعلاقاتهما في عهد الملك عبد الله
- أبرز أسباب توتر علاقات أنقرة والرياض على صعيد الأزمة الخليجية، هو اشتراط الدول المقاطعة للدوحة "إغلاق القاعدة التركية في قطر"
- خسارة ترامب أمام بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كان تطورا حتّم على الرياض رسم مسار جديد لخارطة سياستها الخارجية
- أردوغان والملك سلمان اتفقا قبيل استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين العام الماضي، على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة
- يبدو أن سلسة من المشاكل الخلافية بين الرياض وأنقرة أوشكت على النهاية، لكن يجب ألا ننسى وجود خلافات صعبة يأتي بمقدمتها قضية محاسبة قتلة خاشقجي
- يمكن القول إن حل المشكلات سيكون أكثر صعوبة إذا تولى محمد بن سلمان الحكم، خلفا لأبيه البالغ من العمر 85 عاما
حافظت تركيا والسعودية - البلدان الفاعلان في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي - على علاقات مستقرة لسنوات عديدة؛ إلا أن هذه العلاقات واجهت اختبارات صعبة في السنوات الأخيرة.
النهج الذي اتبعته الرياض وخاصة بعد العام 2015، تخطى المساعي العقلانية، ووصل في بعض الأحيان إلى حد الاستعداء، فكان الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين أمرا محتوما.
ومع ذلك، يمكن القول إنه لن يكون هناك مستفيد من هذا التوتر على المدى الطويل، وإن إعادة تأسيس مجالات التعاون بين البلدين ستنعكس بالفائدة على الطرفين والمنطقة.
قد تبدو أن العلاقات التركية السعودية لن تعود إلى سابق عهدها خلال فترة قصيرة؛ ومع هذا فإن المستجدات التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة شكلت مناخا إيجابيا بين البلدين.
ومع التأكيد على ضرورة اتخاذ حكومتي البلدين خطوات بناءة خلال هذه المرحلة، فإنه يجب تدعيم هذه الخطوات بتوقف الحكومة السعودية عن السعي وراء مزيد من المغامرات، وتغليب "عقل الدولة" قبل كل شيء.
تصاعد توتر العلاقات بين البلدين مع انطلاق ديناميكيات مرحلة "الربيع العربي"، وتفاقم التوتر جراء عدد من المستجدات التي وقعت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ومما لا شك فيه أن أبرز أسباب توتر هذه العلاقات متعلق بالنهج الذي اتبعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي صعد لهذا المنصب عام 2017 بعد عامين من تولي والده الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد العرش في 2015.
اتبع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سياسات لترسيخ سلطته، وانتهج سياسات المغامرة عبر انجراره وراء دولة الإمارات.
من ناحية أخرى يمكن أن توفّر تغير التوازنات في المنطقة واتخاذ عدد من الخطوات الدبلوماسية مع جلوس جو بايدن على كرسي الرئاسة الأمريكية، فرص التقارب بين تركيا والسعودية مجددا.
** نقاط الانكسار من الربيع العربي إلى مقتل خاشقجي
شكلت الحركات الشعبية التي اندلعت أواخر 2010 وسميّت بـ "الربيع العربي"، نقطة انكسار في العلاقات التركية السعودية، وخلال هذه المرحلة، دعمت أنقرة المطالب الديمقراطية للشعوب؛ فيما وقفت السعودية في الصف الثاني ضد ذلك الحراك.
وعلى الرغم من أن التطورات في مصر أحدثت فارقا واضحا بين سياسات أنقرة والرياض؛ إلا أن الجانبين لم يكونا راغبين في مواجهة الآخر.
كانت الرياض من أهم مؤيدي عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري أطاح بالراحل محمد مرسي في 2013؛ ومع ذلك استطاعت تركيا والسعودية المضي قدما في علاقاتهما في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
في 2014 اندلعت أزمة سحب عدد من دول الخليج بينها السعودية سفرائها من دولة قطر، احتجاجا على سياسات الدوحة؛ ومع تدخل الوساطة الكويتية تم حل هذه الأزمة لاحقا.
إلا أن الأزمة الخليجية عادت على وتيرة أشد في 2017، حيث أعلنت دول خليجية بينها السعودية قطع علاقاتها مع قطر، وهو ما وصفته الدوحة بالحصار.
أدت هذه الأزمة إلى توتر العلاقات التركية السعودية، بعد دعوة أنقرة إلى رفع الإجراءات المتخذة بحق قطر والجلوس على طاولة الحوار.
وأبرز أسباب توتر علاقات أنقرة والرياض على صعيد الأزمة الخليجية، هو اشتراط الدول المقاطعة للدوحة "إغلاق القاعدة التركية في قطر".
مع حلول أكتوبر/ تشرين الأول 2018، فتحت صفحة جديدة من الأزمات بين تركيا والسعودية، مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية على يد فريق إعدام جاء من السعودية داخل قنصلية الرياض العامة بمدينة إسطنبول.
بعد هذه الجريمة، أكد المسؤولون الأتراك استعدادهم الدائم للتعاون في الكشف عن خيوط الجريمة، وأطلعوا الرأي العام عن كافة المستجدات المتعلقة بالجريمة؛ إلا أن عدم تعاون الجانب السعودي في التحقيقات أدى إلى تعميق التوتر بين البلدين.
وفي هذه الأثناء، تضمنت تقارير نشرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) معلومات تفيد بضلوع مسؤولين سعوديين كبار في جريمة القتل.
وعلى الرغم من الموقف الإنساني والقانوني لتركيا الذي أبدته في هذه المرحلة؛ إلا أن الجانب السعودي لم يستجب لدعوات التعاون في كشف الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، اتبعت الرياض سياسات مناهضة لتركيا حيال العديد من الملفات بينها المستجدات في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط والقضية الفلسطينية والعلاقات مع إيران، وصولا إلى الحرب بإقليم قره باغ الأذربيجاني.
خلال هذه المرحلة، حاولت السعودية تصعيد التوتر السياسي مع تركيا لتشمل الجانب الاقتصادي، عبر دعم حملات مقاطعة المنتجات التركية، وممارسة ضغوط بحق التجار الأتراك على أراضيها، والضغط على المستثمرين السعوديين في تركيا.
ومن ضمن سلسلة الإجراءات السعودية التي أدت إلى تصعيد التوتر مع تركيا، إغلاق المدارس التركية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحاولات تشويه التاريخ العثماني في الكتب المدرسية، والضغط على وسائل الإعلام التركية.
كما أنه لا يمكن تجاهل تأثير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر على التناقضات في السياسة الخارجية السعودية بالقيادة الفعلية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لقيت كافة محاولات الأمير الشاب الذي انجر وراء سياسات الإمارات، دعم إدارة ترامب الكامل لزعزعة استقرار المنطقة.
إلا أن خسارة ترامب أمام بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كانت تطورا حتّم على الرياض رسم مسار جديد لخارطة سياستها الخارجية.
ومن أبرز اتباع سياسات جديدة في سياستها الخارجية، تصريحات بايدن الواضحة والقاسية وتحركاته تجاه السعودية في العديد من القضايا كمقتل خاشقجي وحرب اليمن وحظر الأسلحة، بجانب احتمال قيام إدارة بايدن بإجراء حوار مع إيران.
وبالإضافة إلى ما ذكر، يجب الإشارة إلى المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها السعودية، حيث ارتفع الدين العام في البلاد 21 ضعفا في السنوات الست الماضية وانخفضت الاحتياطيات إلى 450 مليار دولار.
وتكشف هذه المؤشرات أن الإصلاحات الاقتصادية لولي العهد السعودي لم تحقق النجاح المنشود.
من ناحية أخرى، ينبغي الإشارة إلى سلسلة من المشاكل العالقة في العلاقات التركية الأمريكية التي ينبغي إيجاد حل لها خلال فترة رئاسة بايدن للولايات المتحدة.
** العقل السليم هو مفتاح الحل
خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيس أردوغان، والملك سلمان، قبيل استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين العام الماضي، اتفق الجانبان على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، تلاها تصريحات إيجابية متبادلة من البلدين، لتكون بذلك أولى بوادر تحسن العلاقات.
إن وصول الديموقراطيين سدة الحكم في الولايات المتحدة، قد يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة العلاقات بين أنقرة والرياض، فرغم كون البلدين حليفين تقليدين للولايات المتحدة، إلا أن بعض تصريحات بايدن وإدارته تزعج تركيا والسعودية.
ومن جهة أخرى، تواصل الولايات المتحدة أنشطتها العسكرية في المنطقة، وتعتبر السعودية حليفا مهما لها في هذا الإطار، حيث منحت الإذن للجيش الأمريكي حق الوصول إلى القواعد الجوية في الطائف وتبوك، فضلا عن ميناء ينبع البحري، لكن من جانب آخر، يجب على الديمقراطيين تبني سياسات براغماتية بشكل أكبر، إذ ينتظر مواطنو الولايات من رئيسهم الجديد تنفيذ وعوده الانتخابية.
ورغم انزعاج الرياض من إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إزالة الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، إلا أن نهاية حرب في اليمن سيعزز من مكانة بايدن أمام ناخبيه، وسيقلص من ردود الفعل الغاضبة تجاه مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
والأكثر من ذلك، قد يعتبر هذا الأمر فرصة أمام السعوديين العالقين في مستنقع اليمن سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وفي حال عدم تراجع السعودية خطوة إلى الوراء بالرغم من حظر توريد الأسلحة الأوروبية إليها، قد تشكل الصناعات الدفاعية التركية بديلا مهما لها.
من ناحية أخرى، لا يخفى على أحد محاولة ولي العهد محمد بن سلمان إرضاء إدارة بايدن، من خلال تصريحاته الأخيرة حول حقوق الإنسان، كما لا يعتبر إطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول، بعد 3 سنوات من الاعتقال، أمرا محيرا في هذا الصدد، والأكثر من ذلك يعد احتمال إطلاق سراح المزيد من المعتقلين السعوديين واردا، لكن ورغم ذلك لا يزال هناك عددا من المشاكل الصعبة بين الرياض وواشنطن.
** لا فائز في الصراع
لن يكون من الخطأ القول إن التوتر بين تركيا والسعودية لن يحقق مكاسب للبلدين وعموم المنطقة على المدى البعيد، ويبدو أن سلسة من المشاكل الخلافية بين الرياض وأنقرة أوشكت على النهاية، حيث تم التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.
كما يمكن لتركيا أن تلعب الدور الوسيط في الحوار بين السعودية وجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب الكثير من الأنباء المنتشرة مؤخرا حول نية مصر في إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين لديها، بدعوة من السعودية.
إن مراجعة السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد لسياستها الخارجية وتبنيها سياسات بناءة، قد يلعب دورا في ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين، إذ لن تحقق الرياض أية مكاسب من تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا، وتأييد الأطروحة اليونانية المعادية لتركيا في شرق المتوسط.
ومن جهة أخرى، فإن الاتجاه الإيجابي للعلاقات بين تركيا والسعودية قد يفتح الباب أمام العديد من الفرص، وخاصة في المجالين السياسي والاقتصادي.
لكن من ناحية أخرى، يجب ألا ننسى وجود خلافات صعبة بين البلدين، يأتي في مقدمتها قضية محاسبة قتلة خاشقجي، حيث يُرى ولي العهد أنه المسؤول عن هذه الجريمة، لكن يبدو أن إصدار القضاء السعودي حكما واضحا بهذا الخصوص غير ممكنا، في حين لن تتخل تركيا عن موقفها الإنساني من القضية، ولن تستغل الملف كورقة مساومة سياسية.
وأخيرا، يمكن القول إن حل المشكلات سيكون أكثر صعوبة إذا تولى محمد بن سلمان الحكم، خلفا لأبيه البالغ من العمر 85 عاما.
لكن وكما تدعي بعض وسائل الإعلام الغربية، إذا تم تعيين ولي عهد جديد أكثر خبرة من محمد بن سلمان، قد يتيح المجال أمام تغيرات كبيرة في السياسة الخارجية السعودية، خاصة مع وجود عدد من الأسماء المناسبة لهذا المنصب من أبناء الملك سلمان، وأبناء أشقائه.
إلا أن نفس وسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن تحقيق هذا الاحتمال في المدى القريب يبدو صعبا مع مساعي محمد بن سلمان لترسيخ مكانته في الإدارة السعودية
المصدر:الاناظول.
هل الإنسان مجبر على المعاصي؟
الشيخ محمدرضا الأسدي
الجبر في اللغة هو الإكراه والإرغام والقهر. في علم الكلام: هو إجبار الله تعالى عباده على الفعل خيراً كان أو شراً حسناً كان أو قبيحاً دون أن يكون للعبد إرادة واختيار وقدرة على الرفض والامتناع. وبهذا المعنى اعتقدت الأشاعرة، وهم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وكان معتزلياً ترك الاعتزال على أثر مناظرة حدثت بينه وبين أستاذه محمد بن عبدالوهاب الجبائي في موضوع (الصلاح والأصلح) فتخاصما فإنحاز الأشعري إلى جماعة الصفاتية في الجبر وأيد مقالاتهم بمناهج من علم الكلام في الجبر وجواز رؤية الله وأصبح مذهبه من المذاهب المنتشرة في البلاد الإسلامية، ومن الأشاعرة جماعة عرفوا بأهل التنزيه لم يجوزوا رؤية الله تعالى واعتبروا الأفعال مكتسبة من العباد كما اعتقد بذلك الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان الذي ظهر في ترمذ بمذهبه فقتله سالم بن أحوز المازني ويعتبر مذهبه في الجبر من المذاهب الخالصة المتطرفة في القول بالجبر كذلك المرجئة وهم فرق متعددة يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر حسنة.
وبعبارة أخرى قالت الأشاعرة والجهمية والمرجئة بأنّ الله تعالى هو الخالق لكلِّ شيء ومنه الخير والشر والهدى والضلال والكفر والإيمان وكلّ أفعال العبد مستندة إليه تعالى وليس للعبد قدرة وإرادة واختيار في فعل الشيء وتركه لأنّه مجبر ومكره على كلِّ ما يفعله من خير وشر فالقدرة والمقدور واقعان بقدرة الله وليس لقدرة العبد أثر في أفعاله، وإستدلوا على ذلك بأدلة أهمها:
1- إنّ الله تعالى لو أراد من الكافر الإيمان وأراد الكافر الكفر حصلت إرادة الكافر كان الله مغلوباً وكانت إرادة الكافر الكفر أقوى من إرادة الله تعالى له الإيمان، ولما كان الله لا يغلب على أمره كانت إرادة الكفر للكافر من الله.
2- إنّ كلَّ ما علم الله تعالى وقوعه فهو واقع لامحالة، وما علم امتناع وقوعه فهو يمتنع حتماً فإذا علم الله وقوع الكفر من الكافر استحالت على الكافر إرادة الإيمان.
3- قالوا إنّ في القرآن من الآيات ما يثبت إنّ الله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم وأنّ الحسنات والسيئات آتية من الله تعالى وكلها من عنده، ومن تلك الآيات قوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات/ 96)، (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) (النساء/ 78)، وهكذا تمسكوا بقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) (إبراهيم/ 4)، وقوله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل/ 93)، وغيرها من الآيات التي وردت فيها كلمة الهدى والضلال.
ولكن الشيعة الاثنا عشرية قالوا بالاختيار وهو أنّ الله تعالى كلف عباده بما يريد ونهاهم عما لا يريد بعد أن أقام الحجة وأوضح لهم الدليل وهداهم إلى ما يريده منهم وما ناهم عنه، بعد أن منحهم القوة على فعل الشيء وتركه وإستدلوا على رأيهم هذا بقوله تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) (الإنسان/ 3)، (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) (البلد/ 10)، (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) (البقرة/ 256)، (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) (الكهف/ 29)، وقالوا لو كان الله تعالى يجبر بعض عباده على فعل الشر والكفر والقبيح ويجبر البعض الآخر على الهدى والإيمان والخير لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد ولتساوى المؤمن والكافر بالطاعة لأنّ كلَّ واحد منهما ينفذ إرادة الله تعالى ولا يخالف أمره وثبت أنّ الله تعالى يريد الشيء ويكرهه، يأمر بفعل وينهى عنه ويرغم الكافر على الكفر ويعاقبه عليه ويجبر المؤمن على الإيمان ليثبته عليه واستدلوا على بطلان الجبر وزعم المجبرة بأدلة منها:
1- لو كان الله تعالى يجبر بعض العباد على الإيمان والبر والهدى ويجبر الآخرين على الكفر والشر والضلال وكان البعض منهم مكرهاً على الطاعة والآخر مرغماً على العصيان لبطل التكليف وألغيت كلّ التعاليم والأوامر الصادرة منه تعالى إلى المكلفين لأنّ من شروط التكليف أن يقع الفعل من الفاعل بمحض إرادته واختياره أما إذا كان المكلف مرغماً والمأمور مجبراً على تنفيذ الأمر وكان المكلف (بكسر اللام) قد خلق العل بالفاعل وأوجده فيه دون أن يكون له اختيار وإرادة في خلق الفعل ولا قوة له ولا قدرة على مخالفته والامتناع من حدوثه لم يسم الفعل تكليفاً لأنّ المكلف به محقق الوجود وما كلف به العبد تحصيل حاصل ولا معنى بتكليف العبد بفعل حاصل بقدرة المكلف (بكسر اللام) وإرادته لأنّه حتمي الوقوع إن شاء العبد ذلك أو لم يشأ، أراده العبد أم لم يرده لأنّه مسلوب الإرادة والاختيار.
2- إذا كان المؤمن مجبراً على الإيمان والكافر مجبراً على الكفر بإرادة الله وقدرته ومشيئته كان الكافر والمؤمن متساويين في الطاعة لأنّ الكافر لم يختر الكفر بإرادته والمؤمن لم يرد الإيمان باختياره ووجب على الله تعالى أن يعامل المؤمن والكافر معاملة واحدة فيعاقبهما معاً أو يثيبهما معاً لأنهما لم يختارا الكفر والإيمان لنفسيهما وإنما تم الاختبار بإرادة الله ومشيئته لهما وعلى هذا الزعم يبطل الحساب والعقاب والجنة والنار والوعد والوعيد ويكون الظالم الشرير والخير العادل والمؤمن والكافر في حكم واحد ووجب أن يشطب من تعاليم الله تعالى كلمة الطاعة والمعصية والكفر والإيمان.
3- لو كان الكافر مجبراً والظالم مكرهاً على فعل الظلم لكان للكافر والظالم حجة على الله إذا أدخلهما النار وعاقبهما على فعلهما لأنّه هو الخالق فيهما الكفر والظلم وهذا يخالف ما جاء في القرآن الكريم: (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) (الأنعام/ 149).
4- إذا كان الله تعالى هو خالق الشر والكفر والضلال في الإنسان ولا إرادة للإنسان ولا قدرة على مخالفته وإذا كان الله يجبر بعض العباد على الإيمان والبعض الآخر على الكفر كانت الشرائع والأديان والكتب المنزلة من عنده على أنبيائه ورسله (عبثاً) وكانت دعوة الأنبياء الناس إلى الإيمان بالله وفعل الخير والتجنب من الشر والفساد باطلة ولا أثر للشرائع والأديان في توجيه الإنسان ولا يترتب عليها شيء من أفعال الإنسان ولا تلتزم الناس أحكامها لأنهم جميعهم مسيرون بإرادة الله الذي خلق فيهم أفعالهم من خير وشر وكفر وإيمان ولا قدرة لهم على مخالفة ما أراده الله لهم وكانت دعوات الأنبياء للناس: آمنوا بالله، اقيموا العدل، اجتنبوا الفحشاء لا أثر لها في نفوس العباد لأنّ الذي خلق الله فيه الكفر لا يقدر على الإيمان ومن خلق فيه الإيمان لا يقدر على الكفر كما يقول الأشاعرة والمجبرة والجهمية وغيرهم.
5- لو صح ما ذهب إليه الأشاعرة وأمثالهم من المجبرة من أنّ الإنسان لا إرادة له ولا اختيار فيما يفعل من خير وشر وإنّ القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى وليس للعبد قدرة وإرادة واختيار لكانت القوانين الشرعية والوضعية الخاصة بالعقاب والتأديب غير ملزمة للإنسان وإنما مهما وصفت بالعدل كانت ظالمة للإنسان الذي يرتكب الشر ويقترب الجرائم بفعل غيره فهو إذ يقتل يقتل لا بإرادته وهو إذ يسرق لا يسرق باختياره وإنما يفعل ذلك مجبوراً أو مكرهاً ومرغماً على فعل القتل والسرقة ولا سبيل له غير تنفيذ إرادة من قهره وأجبره فأخذ القاتل بالقتل وقطع يد السارق ومعاقبة أي مجرم في ذلك ظلم لا يتفق والعدل وترك القاتل يقتل والمفسد يفسد في الأرض لا يتفق والمحافظة على الكيان البشري ولا يقول به أي إنسان لأنّ في العقاب سلامة المجتمع وأمنه وفي القصاص من القاتل حياة الإنسان وبقائه كما في قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة/ 179).
6- على زعم المجبرة وأتباعهم: لا يوجد في الدنيا من هو أظلم من الله، تعالى الله عمّا يقول الجاهلون وأي ظلم أفضع من ظلم الله تعالى للإنسان والعياذ بالله لأنّه على زعم المجبرة يجبر الإنسان على فعل الشر ويكرهه عليه ثمّ يعاقبه في الدنيا بحكم ما شرعه من الأحكام الموجبة للعقاب وفي الآخرة يأخذه ويدخله النار ويخلده في عذاب أليم جزاءاً لما ارتكبه من فعل الشر المرغم عليه إن فعلت من عقاب الدنيا.
7- أما ما استدل به المجبرة: من أنّ الله تعالى لو أراد من الكافر الإيمان وأراد الكافر الكفر دون إرادة الله كان الله مغلوباً على إرادته، فإنّ هذا الدليل يثبت الاختيار وينفي الجبر وذلك إنّ إرادة الله تعالى من الكافر الإيمان إرادة تكليفية متروكة إلى اختيار الكافر فلو كانت إرادة الله الإيمان من الكافر تكوينية لتحققت حتماً إرادة الله تعالى دون إرادة الكافر إلّا أن يكون المجبرة قد جعلت إرادة الكافر أقوى من إرادة الله وقدرة الكافر على تحقيق إرادته أعظم من قدرة الله، تعالى الله عمّا يقول الجاهلون وهذا ما لا يقول به أحد من المسلمين.
8- أما ما ذهب إليه المجبرة من أنّ الله تعالى كلما علم بوقوع شيء وقع لامحالة وإذا علم امتناع الشيء امتنع لامحالة هو الآخر دليل لا يجوز على العقلاء وذلك إنّ العلم بالموجودات من الوقوع واللاوقوع ولا علاقة للعلم في إحداث الشيء فالعلم شيء والحدوث شيء آخر، العلم هو معرفة ما يحدث للأشياء والإحاطة بموضوع الشيء وإدراك حقيقته فإذا كان العلم بحقيقة الشيء وما يصدر منه تاماً صدق الإخبار عنه وإن كان ناقصاً كان الإخبار عنه غير صحيح فلو كان العلم عاملاً من عوامل إيجاد الشيء وحدوثه كان المخبر عن الأنواء الجوية وتقلبات الهواء وحدوث الأمطار هو الفاعل المحدث لها وهكذا كلّ من علم بخسوف القمر وكسوف الشمس كان المحدث لذلك إذا صدق علمه.
إنّ علم الله تعالى بما كان وما يكون وما سطره في اللوح المحفوظ وأخبر به ملائكته ورسله لم يكن مؤثراً في أفعال عباده وليس هناك من يشك في أنّ مفهوم العلم هو غير مفهوم الخلق والإيجاد ولا يمكن أن يطلق العلم على الحدث والفعل حقيقة أو مجازاً صراحة أو كناية في مفهوم لغات العالم كلها ولا جدال في أنّ الله تعالى عالم بكلِّ شيء.
9- إنّ ما استدل به المجبرة ومن تبعهم في القول (بالجبر) من الآيات الكريمة المذكورة في الدليل الثالث من أدلتهم لا تدل على الجبر إذا فهم الناس معناها وفسرت على الوجه الصحيح المطابق للحقيقة والواقع. والتفسير الصحيح لما وقع فيه المجبرة من الشبهة في الجبر وقالوا بأنّ الله تعالى هو فاعل الخير والشر، هو في البيان التالي:
قوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات/ 96)، ورد في سياق الآيات المدرجة في سورة الصافات من آية (82) إلى (96) في احتجاج النبيّ إبراهيم (ع) على قومه الذي كانوا ينحتون الأصنام ويعبدونها من دون الله تعالى وهي: (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ * أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ * فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ * فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ * فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ * فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ * قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ * قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ) (الصافات/ 83-97).
إنّ كلَّ مدرك يعي من سياق هذه الآيات إنّ إبراهيم (ع) بعد أن اختبر عبادة قومه راح يسخر من آلهتهم التي نحتوها بأيديهم ويقول لهم ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ثمّ عمد إليها وكسرها بيده اليمنى وحطمها في غياب قومه ولما أقبلوا إليه ووجدوه قد هشم أصنامهم قال لهم إبراهيم على وجه الاستنكار أتعبدون ما تنحتون بأيديكم؟ والله خلقكم وخلق المادة التي نحتم منها أصنامكم فأنتم وما تعبدون من هذه الأحجار التي صيرتموها أصناماً هي من خلق الله تعالى، مستنكراً على قومه إتخاذ المخلوقات خالقاً ومعبوداً، وليس في الآية ما يدل على إنّ الله تعالى هو الذي خلق الأحجار آلهة وأجبر قوم إبراهيم على عبادتها! بدليل قوله تعالى: (أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ) (الصافات/ 95)، أي إنكم تعبدون ما نحتتها أيديكم وصيرتموها آلهة من دون الله.
يضاف على ما تقدم إن إبراهيم (ع) كان في مقام محاججة قومه وإنّه كان يستنكر عليهم عبادة الأصنام من دون الله فإذا كان الله هو العامل لها وهو المجبر لهم على نحتها لما كانت له عليهم حجة فيما أجبر الله تعالى عباده عليه وما خلقه في نفوسهم وأراده لهم وحكلهم على نحته وعبادته.
المصادر:
1- القرآن الكريم
2- تفسير مجمع البيان/ للطبرسي
3- عقيدتنا/ للأنصاري
4- الملل والنحل/ للشهرستاني
5- الفصل/ لابن حزم الظاهري
المصدر: مجلة النور/ العدد 31 لسنة 1993م
واشنطن: لم نضع شروطاً مسبقة لاجتماع "السداسية الدوليّة" مع إيران
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يقول إن بلاده ستواصل استخدام سلطاتها "لإقناع الدول الأخرى بالعدول عن بيع أسلحةٍ لإيران".
- مبنى وزارة الخارجية الأميركية (صورة أرشيفية).
أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن لم تضع شروطاً مسبقة لاجتماع "السداسية الدوليّة" وإيران.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال إن بلاده "ستواصل استخدام سلطاتها لإقناع الدول الأخرى بالعدول عن بيع أسلحةٍ لإيران".
أمّا المتحدّثة باسم البيت الأبيض قالت في وقتٍ سابقٍ إن واشنطن "لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام إلى محادثات الـ 5+1".
في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم السبت، إن التعقيدات الدبلوماسية تعد تمهيداً طبيعياً في عودة جميع الأطراف إلى تعهداتها، وتوقع أن يتم رفع الحظر عن البلاد في غضون المستقبل القريب.
هذا ويجري العمل على "تنظيم اجتماع غير رسمي مع جميع أطراف الاتفاق النووي"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي
كلام المسؤول الأوروبي جاء بعد تأكيد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الخميس، أن الهدف هو "إعادة إيران إلى الالتزام الكامل باتفاق فيينا".
ودعا وزراء الخارجية في بيان إيران إلى عدم اتخاذ أيّ إجراء إضافي في مسار خفض التزامها بالاتفاق النووي، ولا سيما "فيما يتعلق بتعليق البروتوكول الإضافي، وتقييد أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".
وسحبت الولايات المتحدة إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن "واشنطن ستقبل دعوة أوروبية للمشاركة في اجتماع الدول 5+1 وإيران لبحث برنامجها النووي
إلى العدول عن الخطوات المتعلقة بوكالة الطاقة الذرية، وقالت إن مسار "الدبلوماسية لا يزال مطروحاً مع إيران".
نظرية العلاقة الزوجية في القرآن
الشيخ محمّد مهدي الآصفي
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...) (النساء/ 34).
من أهم ما يواجهنا في هذا من البحث مسألة (القوامة).. وقد جعل القرآن الكريم الرجل قيماً على الأسرة عامة، يتولى شؤونها ويرعاها:
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)
وقد أثير حول هذه المسألة كثير من الجدل والتشكيك.
والمسألة كما اعتقد أبسط مما يتصور وليست بهذه المثابة من التعقيد الذي يتعرض لها الباحثون ويتلقاها الناس.
فالأسرة كأي وحدة اجتماعية أخرى مؤسسة اجتماعية لابدّ لها ممن يقوم بشؤونها ويتولى مهام الرئاسة فيها، فما لم تتوفر في محيط الأسرة الإدارة الحازمة لا تنتظم شؤون الأسرة والقوامة لا تتم بدون عنصر الحزم والقوة.
وتكوين المرأة النفسي والفسلجي لا يهيئها لمثل هذه المهمة داخل إطار الأسرة.
والقوامة لا تعني إدارة البيت. فالإدارة شركة بين الرجل والمرأة في محيط الأسرة وربما بين الزوجين والأبناء.. يتحمل كلّ فرد منهم جزءاً من أعبائها والأمر شورى بينهم، وتتدخل الرغبات المعقولة لكلِّ أولئك في تدبير البيت، ولكن شيئاً من ذلك لا يغني عن كلمة الفصل في الإدارة عند الاختلاف داخل البيت.. والكلمة هذه للرجل وحده بعد التشاور والمفاهمة والمطاوعة.
وتكوين الرجل وطبيعة حياته تؤهله لهذه المكانة، فلابدّ أن يتوفر لهذه الكلمة في البيت عند الاختلاف شيء كثير من التدبير يضمن سلامة الأسرة، وشيء كثير من القوة يضمن تنفيذ الكلمة، ولا تملك المرأة ما يملك الرجل في مثل هذه الموقف من حزم وتدبير، والخلاصة انّ الإسلام لكي يكون أمر البيت شورى بين الزوجين، بل يدعو الرجل إلى أن يعطي للمرأة حقوقها في إدارة البيت، وأن يحترم شعورها مطالبها وآراءها.
وفي هذا الجزء من نظام الأسرة يجعل الإسلام إدارة البيت شركة بين الرجل والمرأة.
أما حينما ينشب الخلاف داخل الأسرة فلمن تعود الكلمة الأخيرة؟ هل تعود للمرأة أو الرجل، أو لكليهما معاً؟
ولا يخرج الأمر من فروض ثلاثة:
فأما أن تعود القوامة إلى المرأة وحدها، أو إلى الرجل والمرأة معاً، أو إلى الرجل وحده؟
ولا أعتقد انّ هناك من يؤمن بسلامة الفرض الأوّل فلا تصلح المرأة أن تستقل بشؤون القوامة داخل البيت وما تستلزم من قوة وحزم وتدبير.
وفي الفرض الثاني ينقلب البيت إلى جحيم لا يطاق من الخلافات المحمومة التي لا تنتهي إلى حد بين الرجل والمرأة.
والفرض الثالث هو الفرض المعقول الذي يصح أن يبنى عليه أساس الحياة العائلية الذي يعتمده القرآن أساساً للحياة الزوجية.
2- اشتغال المرأة:
متى أثيرت هذه المسألة:
أثيرت هذه المسألة في أوربا حينما ترك الرجل الأوربي بداية عصر النهضة الصناعية البيت، وهجر الحقل إلى مراكز الصناعة المزدحمة بالعمال، وألقى بنفسه من محيط الريف الهادئ إلى هذا المحيط الجديد الصاخب والمزدحم، وترك من ورائه بيته وزوجه، وانصهر الرجل الأوربي في هذه الحياة الجديدة الصاخبة، ونسي علاقاته في القرية بالأرض وبالبيت وبالزوجة وبكلِّ شيء وأخذ يتقلب في وجوه الحياة الجديدة في المدينة.
لم يكن هذا التطور الجديد من الحياة في أوربا انتقالاً من دور إلى دور، وتحوّلاً من إطار إلى إطار حضاري آخر فحسب وإنما كان انقلاباً اجتماعياً عامّاً شمل مختلف وجوه الحياة الجديدة في المدينة.
لم يكن هذا التطور الجديد من الحياة في أوربا انتقالاً من دور إلى دور وتحوّلاً من إطار حضاري إلى إطار حضاري آخر فحسب، وإنما كان انقلاباً اجتماعياً عاماً شمل مختلف وجوه الحياة، واكتسح الرجال من الأرياف والقرى ومن تلك الحياة الهادئة التي كانوا يمارسونها في الريف إلى زحمة هذه الحياة الجديدة.
ولا يقتصر أثر التقلبات الحضارية عادة على جزء من أجزاء الحياة الاجتماعية من دون أن يصحبها تغير كلي في وجوه الحياة المختلفة واضطراب في القيم والتعاريف الاجتماعية، وتبلبل في الذهنية، وفوضى في التفكير والسلوك.
وقد حصل في أوربا فعلاً ما يشبه هذه الفوضى والاضطراب في الحياة الاجتماعية عامة. فوجدت المرأة الأوربية نفسها وحيدة في محيط الريف ليس هناك من يعولها ويهتم بها، فقد اكتسحت الماكنة شباب الريف ولم يبق هناك غير الشيوخ والكبار من الرجال الذين منعهم الهرم والعجز عن الالتحاق بركب الشباب فوجدت المرأة نفسها مضطرة وهي تعاني الوحدة والفقر أن تهجر القرية بدورها وتحشر نفسها في هذا المحيط الجديد الذي كان يسحر الشباب.. وأن تقتحم على الرجال أبواب المعامل وتزاحمهم على العمل وتشق لنفسها طريقاً إلى الخبز في زحمة هذه الكتل البشرية التي اكتسحت المدن من كلّ جانب، وانجرفت المرأة بقوة مع التيار، واكتسحتها الموجة، وراقها أول الأمر أن تجد نفسها حرة طليقة لا يقيدها بيت ولا يحدها زوج، ولكن سرعان ما أدركت انها لم تخلق لهذا اللون من الحياة وأن تكوينها النفسي والعضلي لا يتلائم مع هذا المحيط الجديد الذي حشرت فيه نفسها حشرا، ولكن الموجة كانت أقوى منها، فلم تعد تستطيع أن تعود إلى البيت مرة أخرى.
وبمن تعود إلى البيت؟ تلك إجمالاً صورة عن قصة المرأة في الغرب.
إنّ المرأة لم تدخل معترك الحياة في الغرب ولم تهجر البيت وما كانت تنعم به فيها من الراحة والاطمئنان باختيار منها، وانما اضطرت إلى ذلك وانجرفت إلى هذا المحيط الجديد ولا تكاد تطاوعها قدماها، ولم تمر المرأة عندنا على مثل هذا الدور ولم تعان شيئاً من المأساة الاجتماعية التي عانت منها المرأة في الغرب، ولم يهجر الرجل البيت ولم يتخل عن زوجته وأطفاله ولم تجد المرأة نفسها وحيدة في البيت قد تخلى عنها زوجها، فلا تجد المرأة عندنا المبررات التي وجدتها المرأة في الغرب للتخلي عن أداءها واجبات الأمومة والزوجية في البيت.
المصدر: مجلة الرياحين/ العدد 70 لسنة 1433هـ
لماذا اليمن والتخلّص من ابن سلمان أولوية بايدن؟
- قاسم عزالدين
في اختياره اليمن أولوية إدارته، يأمل بايدن تضميد جراح أميركا المتورّطة بالهزيمة فيه، لكنه في هذه الأولوية يضع نصب عينيه التخلّص من محمد بن سلمان.
- لماذا اليمن والتخلّص من ابن سلمان أولوية بايدن؟
في رسالة وقّع عليها أعضاء فريق جو بايدن، المرشّح للانتخابات الرئاسية في العام 2018، ينقل وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سليفان أن "الولايات المتحدة مدينة لنفسها ولضحايا الحرب (في اليمن) بأن تتعلّم شيئاً من الكارثة".
الشيء الذي تتعلّمه إدارة بايدن من الكارثة هو الإقرار بمسؤولية أميركا في مأساة اليمن "لأسباب أخلاقية واستراتيجية"، بحسب تعبير بلينكن، الذي أخذ على عاتقه إعادة ملف الحرب على اليمن إلى وزارة الخارجية الأميركية، وإعادة العلاقة مع السعودية إلى مرحلة باراك أوباما بطي صفحة ترامب وابن سلمان.
على وجه السرعة، عيّنت إدارة بايدن المبعوث الأميركي الخاص تيم ليذر كينغ، إلى جانب فريق سياسي وعسكري، لإنجاز المهمة، وهي تأمل إعداد خريطة طريق تعيد الاعتبار إلى أميركا التي مرّغ ابن سلمان وجهها في الوحول اليمنية، ما انعكس على الداخل الأميركي، وعلى أميركا في العالم، وفي السعودية نفسها.
في هذا السياق، بدأت وزارة الخارجية الأميركية الانتقال إلى مقود العربة، بالتراجع عن تصنيف "أنصار الله" ضمن لائحة الإرهاب، وتفعيل قرار الكونغرس ومجلس الشيوخ في العام 2019، القاضي "بالانسحاب من الأعمال العدائية في اليمن".
وعلى الرغم من الإدانة الأميركية لدفاع "أنصار الله" والجيش اليمني في مأرب والجوف، وفي هجومي مطار أبها وخميس مشيط، فإن تيم ليذركينغ يبحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ما سماه "الحل السياسي اليمني"، في إشارة إلى قطع صلة الكواليس بين ابن سلمان وجوقة ترامب.
هذا المنحى أطلق تحرّك "المبعوث الأممي" مارتن غريفيث لأول مرّة إلى إيران، طلباً للمساعدة في الضغط على "أنصار الله"، رجاءً بالتهليل لبايدن وانتظار الآمال الأميركية الموعودة، لكن طهران أرشدته إلى صنعاء التي تقرّر الحل ومواجهة العدوان، وتعيد على مسامعه المبادرة الإيرانية. في المقابل، يوضح القيادي محمد علي الحوثي أن صنعاء لا تأخذ بالأماني ما لم تذهب إدارة بايدن إلى وقف الحصار والعدوان والإقرار بخطوات عملية تدلّ على التكفير عن الجرائم.
طهران وصنعاء ترميان كرة اللهب في ملعب إدارة بايدن لحل أزمات أميركا الناتجة من مسؤوليتها في جريمة العدوان وفي أكبر كارثة إنسانية في اليمن. هذا العدوان أدّى إلى شرخ في الحزب الديمقراطي الأميركي بين جناح بيرني ساندرز الموصوف بالتقدمي اليساري، والجناح التقليدي، فضلاً عن تشقّقات أخرى يمثّلها كريس ميرفي.
هو الشرخ الذي يفرض على بايدن حلّ أزمة الحزب الديمقراطي في المقام الأوّل، أملاً بتجاوز أزمة انشقاقه، كما الأزمة التي يواجهها الحزب الجمهوري بعد سقوط ترامب، ولا سيما أن الجناح المناهض للعدوان على اليمن يعبّر عن متغيرات بنيوية في الديمغرافيا الأميركية، يدلّ عليها ثقل "الأجانب" من غير العرق الأبيض في الحياة السياسية الأميركية، وهو الذي حمل بايدن إلى الرئاسة على ظهر كسر زحف العنصرية البيضاء.
أزمة أميركا الأخرى التي يأمل بايدن تخفيف حدّتها في الإطار نفسه هي المسؤولية عن تمريغ وجهها في الوحول اليمنية، ليس فقط أمام الحزب الديمقراطي والأميركيين "الأجانب" فحسب، بل أمام شعوب العالم أيضاً، وفي مقدمتها الشعوب الأوروبية.
إن الولايات المتحدة هي التي غطّت مشاركة الحكومات الأوروبية في الجرائم بمعيّة ترامب، وما أن تخفّف التغطية بالكلام حتى الآن، يُصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو فيه الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بوقف إمدادات العدوان بالسلاح، وإلى العمل لانسحاب السعودية والإمارات من اليمن.
الأزمة الأعم الأكثر عمقاً التي كشفت عنصرية أميركا في داخلها وخارجها، هي فقدان ما يسميه بايدن "القيَم الأميركية"، فهذه القيَم المتمثّلة بأطروحات حقوق الإنسان والحريات الفردية والديمقراطية الأميركية... هي سلاح ماضٍ في أيدي الإدارة الأميركية، لإشاحة النظر عن نتائج نموذج التوحّش الأميركي في بؤس البشرية وتهديد حياة الكوكب.
هي سلاح تغطية من جهة، وسلاح حرب لزعزعة الاستقرار الهشّ في بعض الدول المعادية لأميركا، من أجل فتح أسواقها وتعزيز المصالح والاستراتيجيات الأميركية من جهة أخرى. إن مسؤولية أميركا عن كارثة اليمن أصابت هذا السلاح بالصدأ طيلة أربع سنوات، ما أدّى إلى تعويل بايدن على أولوية اليمن، أملاً بإعادة شحذه.
المشجَب الذي يسعى بايدن إلى تعليق أوساخ أميركا عليه هو محمد بن سلمان؛ واجهة العدوان على اليمن وأكثر شركاء أميركا وحشية في القتل العاري، وهو يضع نصب عينيه التخفّف من هذه الورطة الثقيلة الأعباء، ليس بسبب كارثة اليمن فحسب، بل بسبب سلاح حقوق الإنسان أيضاً.
والحقيقة أن بايدن لا يقلب في هذا الأمر صفحة ترامب فحسب، إنما يقلب كذلك جانباً من صفحة أوباما مع السعودية وشراكة محمد بن سلمان. ففي مقالة روبرت مالي في "فورين أفيرز" مع ستيفين بومبر، ينقل عن مسؤول كبير في إدارة أوباما، في اجتماع لمجلس الأمن القومي في آذار/مارس 2015، قوله بشأن شراكة ابن سلمان: "كنا نعلم أننا ربما نستقلّ سيارة مع سائق مخمور".
قد يكون هذا المسؤول الكبير هو بايدن نفسه الذي لم يسمّه روبرت مالي، بدليل قطع اتصال بايدن مع ابن سلمان وإزالته عن جدول الأعمال، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، وبدليل آخر أكثر جدية عبّرت عنه إدارة بايدن في عزمها على ملاحقة ابن سلمان في جريمة قتل خاشقجي، بدءاً بنشر تقرير الاستخبارات الأميركية، وعزمها على ملاحقته بتحريك الدعوى التي قدّمها مستشار محمد بن نايف سعد الجبري أمام محكمة واشنطن ضد ابن سلمان وأعوانه.
أزمات أميركا الحادة التي تدفع بايدن إلى مساعي أولوية اليمن والتخفّف من ابن سلمان هي مشكلة أميركا وإدارة بايدن، فإيران وصنعاء معنيّتان بانسحاب قوى العدوان وفك الحصار والذهاب إلى حوار بين اليمنيين لإزالة آثار العدوان والاتفاق على الحل السياسي.
إيران وصنعاء تتقاطعان مع نيات بايدن لحل أزمات أميركا، إذا كان حلّها مساعداً في حل قدّم اليمن في سبيله التضحيات البطولية الخارقة، وتعرّض من أجله لشتى الجرائم ضد الإنسانية، فالمهزوم يعجز عن فرض شروط لم ينَلها بحرب تدميرية، ولا يطلب المساعدة المجّانية لقلع شوكه
المصدر:المیادین
آداب الاستئذان في الإسلام
لقد جعل الله تعالى البيوت سكناً يفيء إليها الناس، فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم ويلقون أعباء الحَذَر والحرص المُرهِقة للأعصاب.
والبيوت لا تكون كذلك إلّا حين تكون حَرَماً آمناً لا يستبيحه أحد إلّا بعلم أهله وإذنهم وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يُحبُّون أن يلقوا عليها الناس.
من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالي ـ أدب الاستئذان ـ على البيوت والسلام على أهلها، لإيناسهم وإزالة الوحشة عنهم، قال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غيرَ بيوتِكُم حتَّى تستأنِسوا وتُسلِّموا على أهلها) (النور/ 27).
(1) تعريف الاستئذان:
هو طلب الإذن ممن تود زيارته حتى لا يُفاجئ بالزيارة في وقت قد يكون فيه مُنشَغِلٌ أو غير مستعد للزيارة فيه وذلك مراعاة لحرمة الإنسان وشعوره وحريته.
(2) حكمه:
الاستئذان واجب على كلّ بالغ يريد الدخول سواء كانت في البيت أمه أم كانت أخته أو ابنته إلّا الزوج فليس عليه أن يستأذن للدخول وليس في البيت سوى زوجته.
(3) آدابه:
يجب على الآباء والمربين أن يُرشدوا أطفالهم الذين لم يبلغوا سن البلوغ إلى أن يستأذنوا على أهليهم (الوالدة، الوالد، الأخت) في ثَلاثةٌ أحوال هي:
1- من قبل صلاة الفجر لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم.
2- وقت الظهيرة (القيلولة) لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال.
3- من بعد صلاة العشاء لأنّه وقت نوم وراحة.
امتثالاً لقول الله تبارك وتعالى: (يا أَيُّها الذين أمنوا ليستأذِنكُمُ الذينَ مَلَكَت أَيَمانُكُم والذينَ لم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ وحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُم مِنَ الظهِيرَة ومِنَ بَعدِ صَلاةِ العِشاء ثَلاثُ عَوراتٍ لَكُم) (النور/ 58).
أما إذا بلغ الأولاد سن الرشد والبلوغ فعلى الآباء والمربين أن يُعلِّموهم آداب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة وفي غيرها امتثالاً لقوله تعالى: (وإذا بَلَغَ الأَطفالُ مِنكُمُ الحُلُم فَليستأذِنُوا كما أستأذنَ الذينَ مِن قَبلهِم) (النور/ 59).
ولا يخفى ما في هذه اللفتات القرآنية من اهتمام الإسلام في تربية الولد اجتماعياً وتكوينه سلوكياً وخُلُقياً، حتى إذا بلغ سن الشباب كان النموذج الحي عن الإنسان الكامل في أدبه وخلقه، وتصرفه واتزانه.
وللاستئذان آداب علمنا إياها رسولنا الكريم (ص) وهي:
أ ـ أن يستأذن ثلاث مرات: لقوله الرسول (ص): "الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع"، ويقول مالك: "الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع فلا أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنّه لم يسمع".
ب ـ أن لا يدق الباب بعنف: ولا سيَّما أن كان رب المنزل أباه أو أستاذه أو ذو فضل... وأما إذا كان على الباب جرس كما جرى العُرف اليوم فيقرع المُستأذِن بقرعة خفيفة لطيفة لتدل على لطفه وكرم أخلاقه ومعاملته.
ج ـ عدم الوقوف أمام الباب: خشية أن يمتد بصره إلى من بداخل البيت لقول النبي (ص): "إنّما جعل الاستئذان من أجل البصر"، "فدلّ على أنّه لا يجوز النظر في دار أحد إلّا بإذنه...".
د ـ أن يُسلِّم ثم يستأذن: لما روى أبو داود أنّ رجلاً من بني عامر استأذن على النبي (ص) وهو في بيته فقال: أألج؟ فقال الرسول عليه السلام لخادمه: "فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي (ص) فدخل".
(4) الحكمة منه:
حتى لا يختلط الرجال بالنساء، وحتى لا يقع الزائر بصره على المُحَّرمات، مما يَحرُم عليه من النظر والله أعلم.
هذه أهم القواعد التي وضعها الإسلام في آداب الاستئذان فما على المربين إلا أن يتقيدوا بها ويُعلِّموها أولادهم إذا أرادوا لهم الخُلُق الفاضل والشخصية الإسلامية المُتميِّزة والسلوك الاجتماعي الخيِّر.
المصدر : التربية الجنسية في الاسلام للفتيات والفتيان لـ عثمان الطويل
المسجد وأثره في حياة الأُمّة الإسلامية
د. محمد بن أحمد الصالح*
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) (التوبة/ 18).. والصلاة والسلام على سيد الأوّلين والآخرين القائل: "من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له به بيتاً في الجنة". المسجد هو مدرسة المسلمين الأولى لإقترانه بالصلاة، والصلاة عماد الدين، ولذا كان المسجد اللبنة الأولى في بناء الجماعة الإسلامية التي وضعها رسول الله صلی الله علیه وآله حين هاجر إلى المدينة المنورة.. وفي فرض الصلاة خمس مرات كل يوم بيان لأثر المسجد في بناء الجماعة المسلمة، إذ جعل الشارع الحكيم بهذه الفريضة المسجد مكان اجتماع المسلمين كل بضع ساعات، لأنّ صلاة الجماعة في المسجد تعلو على صلاة المسلم منفرداً درجات ودرجات، جاء في الحديث الصحيح أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله) قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة". وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنّه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثمّ خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللّهمّ صلّ عليه، اللّهمّ ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة"[1]. وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "علمنا النبي (صلی الله علیه وآله) سنن الهدى وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه" وقال (رض): "حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وانّ الله تبارك وتعالى شرع لنبيه (ص) سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بَيِّن النفاق، ولقد رأيتنا وانّ الرجل ليهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وما منكم أحد إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم"[2]. وجماهير العلماء من السلف والخلف على انّ الصلاة في الجماعة فرض عين بل عدها بعضهم شرطاً في صحة الصلاة[3]. وقد وضع الرسول (ص) بالبيان العملي رسالة هذه المدرسة الإسلامية، ومن مساجد المسلمين خرجت جيوشهم تغزو في سبيل الله، وفيها تخرج العلماء والفقهاء، وفي رحابها كان التقاضي والقضاء ومحاسبة الخلفاء. ولطالما أقام القضاء فيها الجمَّال والحمَّال مع أمير المؤمنين، والأجير والفقير مع الأمير الكبير ثمّ حكموا له أو عليه لا يبالون مع الحق صغيراً ولا كبيراً. وما دهى المسلمين أمر ولا عرض لهم عارض إلا نودي (الصلاة جامعة) فاجتمع الناس في المسجد. ومن وظائف المسجد الاجتماعية أنّه مركز ترابط الجماعة الإسلامية، يتلاقى فيه أفرادها للصلاة وتبادل الرأي، وإليه يرجع مسافرهم أوّل ما يرجع ليؤدي ركعتين "كان النبي (ص) إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه"[5]. وفيه يتم إبرام عقود النكاح فتوضع أسس الأسرة المسلمة في جو من التقوى والهداية، وفيه يهنىء المسلم اخوانه بأفراحهم ومناسباتهم السارة، وفيه يعزي المسلم أخاه إذا أصابه مصاب. ويقف فيه المسلمون على أخبار اخوانهم، ويلتقون في رحابه الطاهر على طاعة الله والتعاون على البر التقوى، فهو بحق منتداهم ومركز مؤتمراتهم ومحل تشاورهم وتناصحهم. واجتماع المسلمين في المساجد يعكس روح الدين الحنيف من مساواة وأخوة، ونظام وترابط ووحدة في الصف، ويربيهم على التواضع والتجرد. ونحن إذا عدنا إلى مسجد المدينة في عهد الرسول (ص) وجدناه مسجدا، وجامعة مكانا يعد للحياة ويدفع للتقدم في كل آفاقها فكل عبادة أو منسك أو شعيرة فيه لها انعكاسها على المجتمع خارج المسجد، فالمسجد إذن قلب المجتمع وعقله، والمجتمع جسم الإنسان وحواسه، ليس هناك أي انفصام بين المسجد باعتباره مركز عمل وتوجيه وبين المجتمع المسلم الكبير – فالمسجد ميدان تطبيقي لكل ما تعلمه المسلم فيه من آداب وقيم تربطه بالآخرين، وبالمجتمع الذي يعيش فيه. وهو المكان الطبيعي لنشر الكلمة المؤمنة الأمينة الموجهة المعلمة التي تزود المسلمين بالعلم والمعرفة في كل ما يتصل بأمور دينهم ودنياهم. انّ الوظيفة الحقيقية للمسجد في الإسلام هي إعداد المسلم المتكامل البناء في خلقه وسلوكه وعمله وعبادته، في علاقته بربه وبنفسه وبأخيه المسلم وبالناس جميعاً، ووظيفة المساجد في صورتها الاجتماعية الشاملة هي أن تكون مركز اشعاع وتوجيه وتربية لمجموعة المسلمين الذين يسكنون الحي الذي يقع فيه المسجد[6]. وأهداف المسجد هي تربية أجيال من الرجال ذوي نوعية خاصة يصفها المولى – عزّ وجلّ في آيات سورة النور: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)(النور/ 36-38). فالمسجد يكمل بناء المجتمع ويدعمه ويقوي أركانه ويعمق في النفوس الحساس بالفضائل التي غرستها الأسرة والمدرسة، بل يغذيهما وينميهما ويتعاون معهما في بناء المجتمع الراشد المتجه نحو الصلاح والفلاح بهداية من الله. وبالتردد على المساجد يتعلم النشئ النظام والدقة والنظافة والاستواء والانخراط في صفوف متراصة مستقيمة. وينمو شعور التآلف بين المصلين فتتكون العلاقات الطيبة وتسود المجتمع روح الخير والأخوة. ورواد المساجد من المؤمنين العابدين الساجدين يتخلصون من العيوب الاجتماعية كالإنعزالية والتواكلية والأثرة، والمسجد يعلم المسلم النظافة والطهارة والتزين دون إسراف اتباعا لقول الحكيم الخبير: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف/ 31). ولأنّ المسجد بيت الله، وبيت جماعة المسلمين، وبيت كل مسلم، فقد كان دوماً في خدمة المسلمين كافة، ولم يستأثر به بانيه كائنا من كان، وهذه الطبيعة الاستقلالية للمساجد جعلتها بمنأى عن الفتن والخلافات، والتأثر بالأهواء، وأتاحت للتعليم أن ينمو في حمى بيوت الله مستقلاً شامخاً يوم كان المسلمون أساتذة البشرية. وذلك راجع إلى أنّ المساجد اتخذت معاهد للعلم، فضمن ذلك كفاءة العلماء من ناحية، وحرية أهل العلم من ناحية أخرى، ومن ثمّ ظهرت تلك الأجيال الرائدة من أهل العلم على طول تاريخنا الإسلامي. وتلك الطبيعة ذاتها هي التي أفسحت المجال لقضاة المسلمين العدول ليجلسوا في حرم المسجد، ليحكموا بين الناس بالعدل، فتحت سقف المسجد وبين أفراد الجماعة الإسلامية أحس القضاة بأنهم يخدمون الجماعة بتطبيق شرع الله، أحراراً من كل قيد. فسطروا صفحات ناصعات في تاريخ العدالة والقضاء العادل. هكذا نظر المسلمون الأولون إلى المسجد على أنّه مدرسة تحمل كل هذه المعاني، فأقاموا صلتهم به على أساسها، فكان له من الأثر في تكوينهم ما لم يعرف التاريخ له مثيلا في أي عمل تربوي بناء. حتى أصبح المسجد بحق المدرسة التي يتعلم فيها المسلم من المهد إلى اللحد كل ما يعوزه من مبادئ الحياة: حياة البيت، فلايتهاون بحق أهله عليه، ولا بحق الله عليهم، وحياة السوق، فلا يخلط الحلال بالسحت ولا يستبدل الخبيث بالطيب، وحياة الحكم فلا يتخذ من عباد الله خولا، ولا من ماله دولا. وإنما ينظر إلى ما وهبه الله من قوة أو ولاه من أمر على أنّه وسيلة لإعلاء كلمة الله، وتحقيق رسالته في عباده. كان العهد بالمعابد أن توقف على الصلاة والتوجيه الروحي، لا تتجاوز ذلك إلى أعمال الدنيا. فإذا المسجد في الإسلام يتسع ويتسع حتى يشمل الدنيا والآخرة، ويتحول إلى أداة لتكوين المجتمع الفاضل، مجتمع الخير المرتفع من الرذيلة المتسامي عن الانحراف والشذوذ – وذلك لأنّ المساجد بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال تعمر قلوب قاصديها بالإيمان وتذكرهم بجلال الله، وتطهر الصدور من الأحقاد وتملؤها حباً وطهراً وعفافاً، وتبدل جهلهم علماً وسفههم حلماً، وتغرس في الناشئة من الشباب حب الخير والرغبة في البر، فالمسجد رسالة عظيمة فلو هيئت له الوسائل والأسباب لقضي على كثير من الجرائم والإنحراف، وليس ادل على أثر المسجد في مكافحة الجريمة من أننا لو أحصينا الجرائم والانحرافات ومرتكبيها لوجدنا مرتكبيها ممن لا يؤمنون المساجد، أمّا الذين يؤمون المساجد فقلما يقع منهم إنحراف أو اعتداء على حق غيرهم، لأنّهم يشعرون بخشية الله، وتربطهم جميعاً الأخوة في الله – هذه الصورة المشرقة كيف اختفت؟ وتلك الأهداف النبيلة للسجد كيف تضاءلت وتواضعت حتى آل حال المساجد إلى ما هي عليه الآن؟. وهناك أسباب أفضت إلى انصراف المصلين عن المساجد نوجز القول فيها كمدخل للحديث عن أوجه الإصلاح المطلوبة ووائله المقترحة بغية العودة بالمسجد إلى دوره العظيم في بناء المجتمع عامة، وفي الدفاع عن هذا المجتمع ضد الانحراف والجريمة خاصة. - أسباب انحسار دور المسجد: يرى بعض الباحثين[7] اجمالها في ثلاث نقاط رئيسة: أ- ضعف الكثير من المسلمين في تمسكهم بدينهم. ب- انخداع بعض المسلمين بزخرف الحياة في المجتمعات غير الإسلامية. ت- البدع والشوائب التي انتشرت لجهل المسملين بدينهم. أ- ضعف الكثير من المسلمين في تمسكهم بدينهم: يعود هذا الضعف إلى زمن بعيد، عندما بدأ المسلمون يفرطون في أمور الدين ولا يأخذونها بالقدر الكافي. وعانى المسلمون من ابتعادهم عن التمسك بما جاء به الرسول (ص) أسوأ ما تعانيه أمة ضلت طريقها واتبعت السبل فتفرقت بها عن سبيل الله وعن صراطه المستقيم. وقد بدأ الانحراف يعرف طريقه إلى المجتمع الإسلامي بالتحلل من القيم الإسلامية عندما وقع بعض حكام المسلمين تحت اغراء الشيطان الذي زين لهم الباطل ولبس عليهم الحق، فضلت خطواتهم الطريق السوي وابتعدوا بأنفسهم عما يجب أن يكون عليه الحاكم المسلم، فكان أن أهملوا وقصروا في صلتهم بربهم، وفي واجبهم نحو من يرعون من المسلمين فظلموا وانتقصوا الحقوق وأهملوا المرافق، وشغلتهم أموالهم وأنفسهم. وامتد الإهمال – بطبيعة الحال – إلى أهم المرافق وهو المسجد. وعلى مثل هذه القدوة السيئة يقع وزر انحراف من اتبعهم في غيهم، فكان إن ابتعدت الرعية عن بيوت الله، وتباعدت المسافة بين أعمالهم وسلوكهم، وبين روح المسجد وأدبه. فصارت الصلاة عندهم عادة وتقليدا، خالية من الروح الحقيقية للعبادة، وأصبح المسجد في حياتهم شيئاً غير ذي بال يتثاقفون في الذهاب إليه عند كل آذان، يخطفون صلاتهم التي أصبحت نقرا كنقر الديوك. هذا الضعف الذي اعترى الأُمّة الإسلامية منشؤه إهمال المسلمين دينهم وتفريطهم في أمره، لأنّ العناية بالمسجد تأتي ممن يهمهم أمر دينهم، أما إهمال المسجد والبعد عنه فنتيجة طبيعية للإبتعاد عن الدين وإهمال أمره. واقترن إهمال المسلمين لمساجدهم وضعف تمسكهم بدينهم بوقوع المسلمين فريسة لشهواتهم وملذاتهم، وذلك لأنهم تجاهلوا ما ندى به الإسلام من ضرورة الاعتدال والقصد في الأخذ بالدنيا حتى لا يصبح المرء عبداً لشهواته وملذاته. والمسجد بما فيه من ذكر لله وعبادة له، وبما له من تأثير في نفوس المسلمين بما يخاطبهم به من عظات وتوجيهات، وهو العاصم الطبيعي للمسلم من أن تستبد به شهواته أو تشتط به غرائزه. ولكن بتخليهم عن المسجد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وانتشرت الخبائث واجْتراء الكثير من الناس على الموبقات فاخذت الخمر وهي أم الخبائث تجد سوقاً في بلاد المسلمين، وتقف القوانين الوضعية عاجزة أمامها وأمام ما تنشر من مفاسد، وشاهدنا عودة الميسر والجرائم الخطيرة التي تنجم عن انتشاره بصوره المختلفة، علاوة على ما يسببه من تبديد للأموال وخراب للذمم وذلك بالإضافة إلى ما ابتليت به مجتمعات المسلمين من الزنا والربا المتسببين في ضياع الأُمم السابقة. وأصبح ضياع الأُمّة واقعاً مؤكداً، وتحقق فيها قول الله تعالى عمن يضيع الصلاة: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) (مريم/ 59). ب-انخداع بعض المسلمين بزخرف الحياة في المجتمعات الإسلامية: عندما كان المسلمون متمسكين بدينهم أقوياء العقيدة لم يضرهم اتصالهم بأبناء المجتمعات غير الإسلامية والاطلاع على طريقة حياتهم، بل انّهم كانوا يأخذون منها ما يتفق مع الإسلام، ويتركون ما يختلف مع جاء في كتاب ربهم وسنّة نبيهم (ص). كانت تلك معايير تعامل المسلمين مع ما وجدوه عند غيرهم حينما كان المسلمون ملتزمين بمنهج الإسلام وأخلاقه وآدابه. فلما اعترى المسلمين الضعف لتراخيهم في الالتزام بأوامر الدين تغير موقفهم ولم يجدوا غضاضة في تقليد غير المسلمين دون وعي، فأتاحوا لغيرهم أن يغزوهم فكرياً وعقدياً وحضارياً. ويكفي لإثبات صحة ما نقول أن نأخذ مظهراً واحداً من مظاهر التأثير السيء لغير المسلمين على أفكار المسلمين ومساجدهم. فعندما نجحت الصليبية الأوروبية في احتلال أراضي المسلمين وجدت الفرصة سانحة للتنفيس عن أحقادها على الإسلام باعتباره القوة الوحيدة التي بها يستعيد المسلمون سابق مكانتهم، ويردوا بها كيد أعداء الله إلى نحورهم. فعمل أولئك المستعمرون على إبعاد المسلمين عن دينهم وإبدالهم فكراً أوروبياً بفكرهم الإسلامي. ولكي يتحقق لهم ذلك بذلوا ما وسعهم من جهد في تنفير المسلمين عن دينهم الحنيف، وتشويه حقائقه، والطعن في رسولهم الكريم (ص) وصحابته الأبرار – رضوان الله عليهم –. فكانت مدارس التنصير ومعاهد الاستشراق ونوادي الماسونية والصهيونية أهم وسائل هذا الهجوم الشرس ولمعرفتهم بأهمية المسجد فقد أجمع أعداء الإسلام على حربه، واتبعوا لذلك وسائل شتى. منها إيجاد مؤسسات استعمارية بديلة، فأنشأوا مدارس وملاجئ ونوادٍ ومستشفيات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فمظهرها الخارجي بريء خداع يجذب المسلمين من أصحاب الحاجات أو من السذج الغافلين. أما حقيقة تلك المؤسسات، وهي الهدف الذي من أجله أنشئت، فهي التنصير وإخراج الناس من دين الحق. وكان همُّ من أجدوا تلك المؤسسات أن تسرق من المسجد رسالته، فكان لهم ما ارادوا. كما حاولوا القضاء على التعليم الإسلامي، فحرمت المساجد العنصر البشري من أئمة وعاظ، وحاربوا العاملين في تلك المؤسسة بالوسائل الإعلامية التي تحت أيديهم من صحف ومجلات ومسارح بأن سخروا منهم واستهزأوا وشوهوا صورتهم أمام أبناء وطنهم. فهانت في أعين عامة المسلمين صورة أهل العلم من بينهم ونفروا منهم[8]. ت- وكانت البدع والشوائب التي علقت بالعبادة في المساجد نتيجة لجهل المسلمين من الأسباب التي حالت بين المسجد وبين أداء وظيفته، تلك والخرافات التي اتصلت بالمسجد ودخلت عليه بالتحريف والتشويه وشاعت بين الجهال من المسلمين شيوعاً كبيراً. ولو أخلصنا النيات ووحدنا الجهود لتخليص المسجد من تلك السلبيات وأزلنا الأسباب التي تقعد بالمساجد عن أداء دورها لصلح أمر المجتمع ولاستطاعت هذه المساجد العريقة الاسهام بالنصيب الأوفى في محاربة الجريمة والوقاية من الزلل والإنحراف. إنا نرى هذا الدور المنشود أكبر من أن تحدده الألفاظ ولعلّ السطور التالية توضح أهم قسماته: أوّلاً: تقوية الجانب الديني في نفوس الناس بما يتلقونه من وعظ وارشاد وتوجيه يعصمهم من الوقوع في المعاصي، ويجعلهم من عناصر الخير في المجتمع. ثانياً: ارتباط المصلين بالمساجد يدفع المصلين إلى الابتعاد عن الفحشاء والمنكر والبغي وسائر الموبقات. فالصلاة جماعة تنشئ الاتحاد والمحبة والإخاء بين المسلمين، وتجعل منهم كتلة متراصة، فانهم عندما يجتمعون ويقنتون لربهم ويسجدون له ويركعون معاً تأتلف قلوبهم، وينشأ فيهم الشعور بأنهم اخوة فيما بينهم، ثمّ انّ الصلاة في جماعة تدربهم وتربيهم على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات، وتنشئ فيهم المواساة والتراحم، والمساواة والإئتلاف، فتراهم جميعاً غنيهم وفقيرهم، وكبيرهم وصغيرهم، وأعلاهم وأدناهم، يقومون جنباً إلى جنب، "في صفوف متلاحمة لا فرق بين قوي ولا ضعيف، ولا رفيع ولا وضيع". ثالثاً: الخشوع لله الذي يحس به المسلم في صلاته، ويدفعه إلى البعد عن الانحراف، فضلاً عن ارتكاب الجرائم، لما تفعله الصلاة بالإنسان من تطهير نفسه، والارتقاء بروحه، وإصلاح أخلاقه وأعماله. رابعاً: كما انّ المساجد التي تهيئ لروادها التزود بشعور التضامن والأخوة الناشئ من اجتماعهم للصلاة في الجمعة والجماعات والأعياد، وتوجد في هؤلاء المصلين الرغبة في معاونة بعضهم بعضا، وتنزع من أفئدتهم الرغبة في اعتداء بعضهم على بعض بأي نوع من أنواع الاعتداء. خامساً: ومن شأن الدروس التي تلقى في المساجد أن ترتقى بتربية الخلق والضمير إلى أعلى المستويات مما يشيع روح الفضيلة والمثالية فيسود المجتمع جو دائم من الهدوء والسكينة والقناعة والرضا. سادساً: في هذا الجو الذي يسوده الصفاء الروحي والسكينة تصبح المساجد هي المكان الأمثل لإصلاح ذات البين ولاجتماع لجان الصلح بين المتخاصمين والمتنازعين، وفي الصلح قضاء على كثير من الجرائم، بل وعلى التفكير فيها. سابعاً: يجب أن نعمل على تحبيب المساجد إلى الناس وإلى شبابهم على وجه الخصوص، بالعناية بنظافتها ومظهرها والحرص على اختيار القائمين عليها من الأكفاء ثقافةً وورعاً، ومراقبتهم في مظهرهم ولباسهم، والتوسيع عليهم في أرزاقهم بما يمكنهم من الظهور بالمظهر اللائق الذي يدعو إلى الاحترام والتوقير. لأنّ عامة الناس وشبابهم على وجه الخصوص، تخدعهم المظاهر عن الحقائق، ويتأثرون بالمظهر والصورة عن الجوهر والمخبر. ثامناً: من المفيد أن نعمل على ربط الناس بالمساجد، باختيار لجان من صالحي روادها من أهل الأحياء التي تقع فيها، لمراقبة حسن أدائها لوظائفها واقتراح ما تراه معينا عليه. *جامعة محمد بن سعود الإسلامية - الرياض
الهوامش:
[1]- البخاري، باب الصلاة 1/ 166 طبعة عيسى البابي الحلبي – القاهرة. [2]- صحيح مسلم رقم 654 في المساجد باب صلاة الجماعة من سنن الهدى وأبو داود رقم 550 في الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2/ 107 في الامامة باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن. [3]- فتح الباري باب وجوب صلاة الجماعة 1/ 126. [4]- البخاري كتاب الصلاة/ 1/120. [5]- علي عبدالحليم محمود، المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي، القاهرة 1396هـ، ص173-174. [6]- علي عبدالحليم محمود، المرجع السابق ص79 وما يليها، بتصرف.
[7]- علي عبدالحليم، المرجع السابق، ص90.
المصدر: مجلة هدي الإسلام/ العدد 28 لسنة 1984م
المرأة في مناخات مختلفة
السيِّد حسين نصر
منذ ظهور مبدأ المساواة بين الجنسين (feminism) كتبَ المراقبون الغربيون بمقدار أوراق الشجر في حقوق المرأة في الإسلام، وقد جَعلَت تلك الكُتُب من الطرح الغربي معياراً توزَن به المرأة في بقية المجتمعات وكيفية التعامل معها، ويتجّه الغرب اليوم إلى نحو ما، نستطيع أن نُسمّيَه (الإطلاق في المحدود)، وهو أنّ الإنسان في كلّ عهد، يضفي صفة الإطباق على فكره وأعماله، من دون أن يلاحظ أنّ تلك الأفكار والرؤى والمعتقدات ستُدفن في العقد الآتي وستصبح في طيّ النسيان، ولا تتضح هذه الظاهرة في أمر كظهورها في مسألة حقوق المرأة وواجباتها، فإذا بُحثت تلك المسألة في عام 1900م في الغرب، وكانت المعايير تختلف فيها من وقت لآخر، فإنّها سوف تشهد أحكاماً ونتائج أخرى في عام 2100م.
والأحرى بالغرب، وبدلاً من تناول مسألة المرأة في الإسلام بالطعن والتشنيع وتهيئة مناخات لمرحلة جديدة من الحروب الصليبية، أن يدرس هذه المسألة من وجهة نظرٍ إسلامية، ومن ثمّ يطرح ما عنده من انتقادات على أساس المعايير التي عرفها وفهمها؛ قبل كلّ شيء يجب أن نعرف أنّ الأعراف الموجودة في المجتمع الإسلامي لم تكن أعرافاً ورسوماً إسلامية فقط، بل قد تكون رسوماً وعادات اعتادها المجتمع، وليس له ربط بالإسلام، في الشرق الأوسط مثلاً اعتادت بعض النساء غير المسلمات كاليهوديات والمسيحيات تغطيةَ شعورِهنّ ووضع قطعة من القماش عليه، وكذلك القناع الذي يغطي الوجه (الخمار)، فإنّه لم يُذكر في القرآن، ولم تستعمله النساء المحيطات بالنبيّ (ص)، ولكنّه أخذ من رسوم وعادات الإيرانيين والبيزانطيين.
ومع ملاحظة أنّ المرأة لم يكن لها حضور في الفعاليات الاجتماعية والسياسية إلى ما قبل المرحلة الجديدة في المجتمعات غير الإسلامية، كاليابان والصين، وبقية المجتمعات الآسيوية، فإنّ من غير الصحيح أن يوسم المجتمع الإسلامي بالدكتاتورية أو ما يسمونه (الطبيعة الأبوية) أي أنّ المجتمع الإسلامي يقتصر في إدارة شؤونه على الرجل فقط، ويفرض على المرأة قيوداً ويحدّ من نشاطاتها، وأنّ هذه الظاهرة كما يعتقدون هي الشاخص الواضح للإسلام.
إنّ التعاليم الدينية تعدّ المرأة والرجل متساويين عند الله، وعلى مستوى الشريعة، وتؤكّد على أنّ أحدهما يكمّل الآخر في الأسرة والمجتمع، وهذا التساوي بينهما في مقابل الله والشريعة لا يتنافى مع كون أحدهما يكمّل الآخر.
كثيرون سألوني: هل المرأة متساوية مع الرجل؟ وكان جوابي دائما هو: أنّهما متساويان نسبةً إلى الله وفي يوم القيامة وأمام القانون، لكنّهما ليسا متساويين في هذا العالم، وقد أشار إلى حقيقة تلك الاختلافات الكتّاب الأمريكيون تحت عنوان (رجال المرّيخ ونساء الزهرة).
إنّ بناء المجتمع الإسلامي مرسوم على أساس تماثل الرجل والمرأة لا على أساس الكمية مع وجود استثناءات في هذا السياق، فالرجل يؤمّن لقمة العيش، وبتعبير ديني (إمام الأسرة)، والمرأة في الواقع هي المديرة لشؤون البيت والرجل كالضيف عندها.
إنّ أوّل وظيفة للمرأة هي تربية الأطفال والحفاظ عليهم وتعليمهم في مراحلهم الدراسية الأولى، وهي أيضاً عماد البيت. إنّ الإسلام وكيفية المجتمعات التقليدية يعطي للأُمّومة والتدبير المنزلي للمرأة أهميةً كبرى، وقد قال الرسول (ص): "الجنّة تحتَ أقدامِ الأُمّهاتِ".
ولم يرجِّح في المجتمع الإسلامي يوماً ما عملُ المرأة في الخارج على وظيفتها في تربية الأطفال، من جهة أخرى، إنّ النظام الاقتصادي الذي كان حاكماً في المدن الإسلامية آنذاك كان من البساطة بمكان بحيث إنّ المرأة لم تضطر للخروج من بيتها أو ترك أولادها من أجل متطلبات الحياة.
فالطفل في نظر الإسلام يحتاج إلى الأُمّومة دائماً، بدلاً عن المربية والحاضنة، وهذا الحقّ أهم وآكد من كثير من الحقوق والتي يلهث وراءها الغرب.
وإنّ النساء المسلمات يتمتعن بقدرة وقوّة كبيرتين في بيوتهن، وأنا أعرف الكثيرات من الأُمّهات - من طرَف الأب والأُمّ - كن يحملن قدرة ومنعة تفوق بكثير قدرة الأُمّهات اليهوديات والإيطاليات، وكلّ مَن يدّعي أنّ المرأة ضعيفة في المجتمع الإسلامي ومحرومة ومظلومة فهو غير مُدرك للبناء والمسار الحياتي للمسلمين.
قد يُوجد بعض الرجال في المجتمع من الذين يقعون تحت سلطة نسائهم، لكنّ هذا ليس بأكثر مما يقع في مجتمعات أخرى، ومع ذلك وبالرغم من إرشاد القرآن وتأكيده على تكريم المرأة وحُسن معاملتها كما نقرأ في القرأن: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء/ 19) يُوجد من المسلمين مَن يُسيء معاملة زوجته، سواء في الماضي أو الحاضر، ومع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الذي كان سائداً في الجزيرة العربية قبل الإسلام، فإنّ القوانين الدينية والأحكام الإسلامية، أوجَدت تغييراً ملحوظاً في سياق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ووقفت ضدّ الممارسات غير اللائقة بحقّها؛ لكن، لا يخلو الأمر من أنّ هناك من الأزواج في المجتمع الإسلامي كما في غيره مَن يتعامل بوحشية مع زوجته وفاقاً لطبيعته النفسية وبنائه الوجداني، حتى تصل النوبة إلى الضرب المبرّح، ووجود مؤسسات الإغاثة الغربية والأمريكية التي تستقبل النساء اللواتي يعانين من ظلم أزواجهن دليلٌ على وجود هذه المشكلة (ظلم المرأة) التي هي مشكلة العالم ولا ترتبط بمكان دون آخر.
كما قلنا من قبل: إنّ المسؤولية الاقتصادية للأسرة تقع على عاتق الرجل، حتى وإن كانت الزوجة غنية، ولابدّ من النظر إلى الحُكم القرآني بإعطاء الرجل ضعفَ ما تُعطى المرأة في الإرث بأنّه حُكم ناظر إلى مسؤولية الرجل في تأمين الحاجيات المادّية للأسرة، وإنّ المرأة حرّة في التصرّف في أموال الزوج والانتفاع منها بحدود المعقول.
إنّ قيمومة الرجل على المرأة التي وردت في الآية الكريمة: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) (النساء/ 33) يُفهم منها القيمومة الاجتماعية والاقتصادية، وليس القيمومة على كلّ حياة المرأة، وحتى شهادة المرأة واعتبار أنّ شهادة رجل واحد تعادل شهادة امرأتين، إنّ البعض من الفقهاء يحدّد هذه المسألة في موارد الشهادات والجرائم، ولا تشمل كلّ أنواع الشهادات.
والقرآن في هذا الحُكم يبيّن الطبيعة العاطفية لدى المرأة، وليس في صدد تحقيرها أو التقليل من شأنها، ولا يُوجد في المصادر الإسلامية حُكمٌ يمنع المرأة من العمل وأخذ الأجرة عليه، وفي المجتمع الإسلامي، كانت المرأة دائماً إلى جانب الرجل، في أعمال الزراعة، وفي كثير من الفنون والصناعات، وإلى اليوم، إنّ أكثر السجّاد في الدول الإسلامية تقوم بحياكته النساء.
وقد أعطى الإسلام المرأةَ الاستقلالية الاقتصادية، إذ تستطيع المرأة أن تستقل مادّياً حتى عن زوجها، وعلى هذا أصبح أغلب تلك النساء، وعلى مدى القرون يمتهنَّ التجارة، كخديجة زوج النبيّ (ص)، على هذا المنوال فإنّ الأصل هو عدم المانع دخول المرأة المسلمة في المعترك السياسي.
وفي ما يرتبط بالتعليم، جاء عن النبيّ (ص): "إنّ طلبَ العلم فريضةٌ على كلّ مسلمٍ ومسلمة"، لكن على امتداد التاريخ الإسلامي كانت الفتيات المسلمات يكتفين بدارسة دورة قرآنية فقط، وكانت القليلات منهنّ يصلْنَ إلى مراتبَ عالية في الدراسة، ولم تكن تلك الظاهرة وليدة التعاليم الإسلامية، بل كانت الأوضاع الاجتماعية تقتضي ذلك، وقد تصل المرأة في التعليم والمعرفة إلى مصافّ العلماء في التعليم.
إنّ نظرة الإسلام إلى المرأة تجعلنا نعود إلى مسألة الحجاب، وقديماً كان لدى الغرب انطباع مشوَّهٌ ومحرّف عن العالم الإسلامي، تكون المرأة فيه محجّبة ومحتشمة خارج البيت، ومبتذلة وخليعة مضطجعة إلى جانب مسابح البيوت، وقد صوّر ذلك المستشرقون في لوحات ورسوم في القرن التاسع عشر، غير أنّ هذا التصوير يرتبط بالإضرابات التي حدثت في الغرب ضد القيود الجنسية التي فُرضت في عصر (فكتوريا)، والتي تعود إلى البرنامج الجنسي في المسيحية، مع هذا فإنّ تلك الصور لنساء مسلمات تعود لمجتمع متغرّب، غير صحيح أساساً وفي مراحل الاستعمار، كان الغربيون يعدّون الحجاب رمزاً لمظلومية المرأة، والحطّ من منزلتها وكان يوافقهم في ذلك أهل الحداثة (الإصلاحيون) من الخط الإسلامي.
وإنّ القرآن الكريم يأمر الرجل والمرأة بلباس الحشمة (التحجب) وأن لا يُظهرَ كلٌّ منها أعضاء بدنه، وقد اعتبر النبيّ (ص)، الحياءَ من الخصوصيات المهمّة في شخصية المسلم، وأمرالإسلامُ المرأةَ أن تخفي زينتها (الزينة بمعنى الشعر والبدن)، وعلى أساس ذلك ظهر الكثير من موديلات الألبسة في نواحٍ مختلفة من العالم الإسلامي، وإن كان البعض منها يعود إلى المجتمعات القديمة - قبل الإسلام في الشرق الأدنى - وفي المجتمعات الأولى لليهود والمسيحيين تعمل المرأة على تغطية شعرها، وحتى على مستوى الفنون فإنّ الفنانين الغربين يعمدون إلى إظهار مريم العذراء في فنّ الرسم محجّبة، وإلى مدّة ليست بعيدة كانت المرأة المسيحية الأرمنية والكرجية، والمرأة اليهودية والشرقية تغطي شعرها كالمرأة المسلمة.
وكانت تغطية الشعر من العادات الطبيعية في حياة النساء، وهي تمثل التواضع والاحترام لله عزّوجلّ، وحتى في الغرب، وإلى ما يقارب جيلاً واحداً، كانت نساء الكاثوليك لا يأتينَ إلى الكنيسة حتى يقمْن بتغطية شعورهنّ. ثمّ مَن قال: إنّ كشف الرأس موجب لحرّية المرأة أكثر من الحجاب؟
إنّ مسألة الحجاب، والكثير من الموضوعات المرتبطة بالتعليم والتربية والقانون، وكثيراً من القضايا المهمّة، أصبحت مَورداً لاهتمام مجموعة من النساء المسلمات اللواتي يتطلّعن إلى مجتمع على غرار النموذج الغربي القابل للتغير دائماً، وقد وضعْنَ أيديهَنّ بأيدي دُعاة المساواة بين الرجل والمرأة الغربيين، من أجل تخريب المجتمع الإسلامي وتحويله إلى مجتمع لا دينيّ.
وللأسف، إنّ دُعاة المساواة في الغرب غير مستعدين لفهم الفلسفة الأساسية للعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام، وفي المجتمعات غير الغربية. كما أنّهم غير قادرين على تقديم بديل واضح عن ذلك له معنى ومفهوم تقبله المرأة المسلمة.
وفي العقدين الأخيرين ظهرت في بعض المجتمعات الإسلامية حركات نسائية جديدة تطالب بحقوق المرأة، وتعتقد أنّ هذه الحقوق تتطابق مع القرآن والسُّنة، وإلّا أنّ الآداب والرسوم والأعراف المحلّية، حالت دون تحقّق هذا الأمل. وهذا المبدأ في المساواة بين الرجل والمرأة حسب الطرح الإسلامي أنسبُ من المبدأ الغربي في ذلك لأنّ أغلب النساء اللواتي يطالبنَ بالمساواة هنّ نساء مؤمنات يفعلنَ ذلك في إطار الرؤية الإسلامية. ومن جهة أخرى، فإنّهن أدرى بمشاكلهن الحقيقية من نظيراتهن الغربيات.
وعلى أيّ حال، إنّ مسائل المرأة في التعليم والحقوق القانونية ومشاركتها وفعاليتها في السياسية واحدةٌ من أعقد المسائل التي ابتُلي بها العالم الإسلامي.
ويسعى المجتمع الإسلامي إلى حلّ هذه المسألة على أساس الآداب والرسوم الإسلامية في أجواء تتسم بالضغوط الغربية.
المصدر: كتاب قلب الإسلام قيم خالدة من أجل الإنسانية
الغنوشي يطالب بلقاء بين أقطاب السلطة لحل الأزمة السياسية
ما يزال الرئيس قيس سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية حيث يتحفّظ على بعض الأسماء "لتورطها في شبهات فساد"
الغنوشي تحدث عن تنامي الخطاب التحريضي واستفحال الأزمات المركبة في تونس
دعا رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي اليوم السبت إلى العمل على علاج الأزمة السياسية في البلاد من خلال الحوار بين الأطراف الرئيسية في السلطة، وبطريقة تعكس أن تونس دولة مؤسسات.
واقترح الغنوشي على الرئيس عقد لقاء يجمع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في أقرب وقت من أجل الأزمة السياسية الراهنة
وأوضح بيان لمجلس النواب أن الغنوشي دعا في رسالة وجهها للرئيس سعيد إلى تجميع الفرقاء، من أجل إيجاد حلول لما تعيشه البلاد من "أزمات مركبة".
وشدّد الغنوشي على ضرورة إيصال رسالة إيجابية للمواطنين ودول العالم بأن تونس دولة مؤسسات جديرة بالثقة، رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، على حد تعبيره.
يأتي ذلك في وقت تتواصل أزمة التعديل الحكومي بين رئيسي الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية، منذ نحو شهر.
وأوضحت مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي أن مبادرة الغنوشي تكسب أهميتها من كونها تدعو للقاء مباشر بين الأطراف الرئيسية في السلطة.
رئيس والوزراء
ويعد تعطيل الرئيس سعيد للتعديل الوزاري من أبرز مظاهر الأزمة السياسية في البلاد، كما أفادت مراسلة الجزيرة.
وأشارت المراسلة إلى أن هذا التعديل نال ثقة البرلمان قبل 3 أسابيع، لكن سعيد يرفض دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية، حيث يتحفّظ على بعض الأسماء "لتورطها في شبهات فساد".
اعلان
ومن جانبه قال الناطق باسم حركة النهضة فتحي العيادي إن مبادرة الغنوشي تأتي تقديرا منه بأن البلاد تعيش أزمات كثيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي، ولكنها بحاجة لما هو أهم وهو التهدئة وتنمية روح التضامن الوطني.
وأضاف العيادي أن المبادرة تأمل من رئيس الدولة باعتباره رمز وحدتها أن يسعى إلى تأليف وجمع كلمة التونسيين، وبث الروح الوطنية في هذه اللحظة العسيرة من تاريخ التجربة التونسية.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي للبحث عن توافقات ضرورية لحل الأزمة السياسية التي تمثل عائقا أمام أي حل لبقية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس.
المصدر : الجزيرة + الأناضول