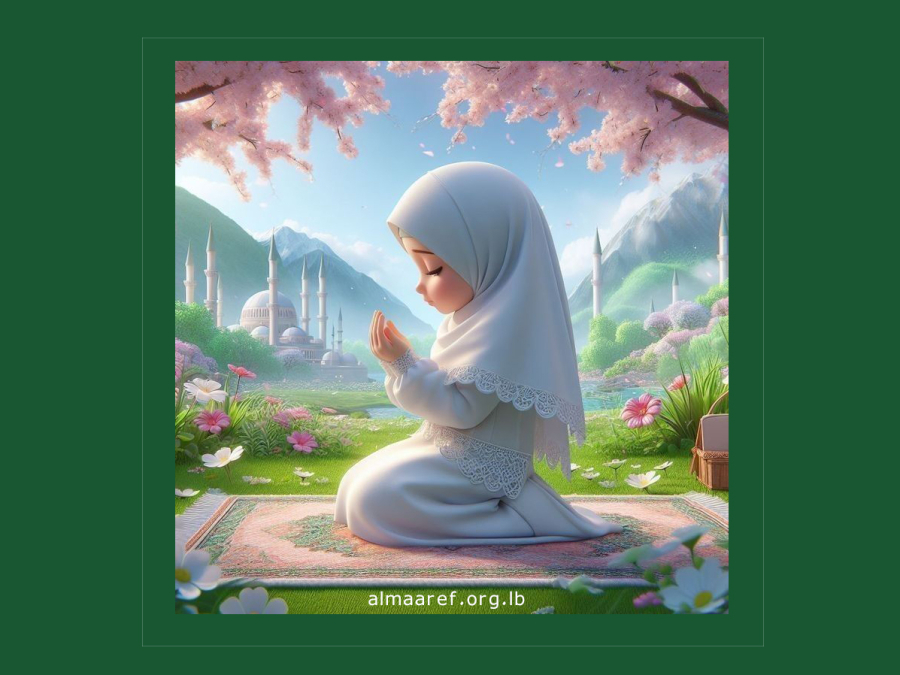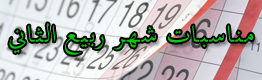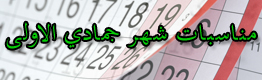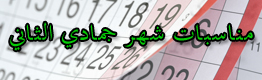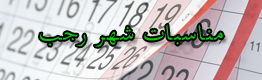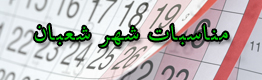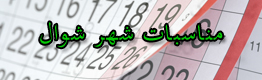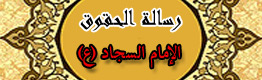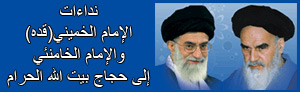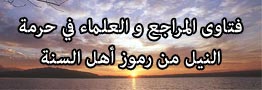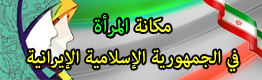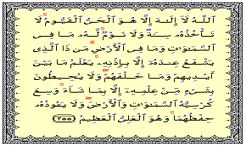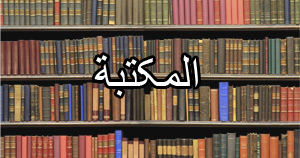في الجواب عن هذا السؤال، يمكن طرح أساليب عدّة لاستفادة المربّي منها في التربية العقائدية للطفل، وهي على النحو التالي:
أولاً: أسلوب التلقين اللفظيّ
وعمدة هذا الأسلوب: تعويد الطفل على تكرار بعض الجمل والمقولات على المستوى اللفظيّ حتّى لو لم يفهم معانيها، مثل تكرار قول: لا إله إلّا الله، أو محمّد رسول الله...، فإنّ نفس هذا التكرار له دوره وتأثيره الخاصّ في تفتّح الحسّ الإيمانيّ بالله تعالى.
ويجب على المربّي اعتماد هذا الأسلوب في الطفولة المبكرة (3 سنوات)، وهو أسلوب اعتمدته روايات أهل البيت (عليهم السلام)، فقد روى عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام)، قال: سمعته يقول: "إذا بلغ الغلام ثلاث سنين، يقال له: قل: لا إله إلا الله سبع مرات..."[1].
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: "افتحوا على صبيانكم أوّل كلمة لا إله إلا الله"[2].
ثانياً: أسلوب معرفة قانون السببية
إنّ تربية العقل على التفكير بالأمور والربط بين الأشياء والتعرّف على أسبابها يلعب دوراً في تنمية الإحساس بالله تعالى.
والطفل يلتفت إلى الأصوات ويربطها بأسبابها، وهذا إنّ دلّ على شيء فإنّه يدّل على أنّ قانون السببية أمر فطريّ عنده، وعلى المربّي أن يعمل على تنمية هذا الشعور في نفس الطفل وتحويله شيئاً فشيئاً إلى شعور واعٍ.
في البداية على المربّي أن يُنمِّي لدى الطفل حسّ المعرفة والاكتشاف، ويجعله يدرك أنّ وراء كل ظاهرة يوجد سبب مؤثر في وجودها، فصوت النباح سببه الكلب،... إلخ، ثمّ يتدرّج معه في عملية الربط بين الأشياء لينتقل إلى عملية الربط بين خصوصيات الأشياء وأسبابها، بمعنى إذا رأى لوحة جميلة يدرك أنّ الرسّام ماهر، بعكس لو كانت غير جميلة فيدرك عندها عدم مهارة الرسّام، فيسعى إلى تنمية هذا الحسّ للطفل مع كل مرحلة عمرية، وبشكل تدريجيّ ستنمو معه هذه الحالة ويتعرّف لاحقاً أنّ لكلّ ظاهرة في الحياة إلهاً وخالقاً وهو سبب الأسباب كلّها، وهذا ما نلمسه في منهج أهل البيت عليهم السلام، فعندما سئل أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) عن إثبات الصانع، أجاب: "البعرة تدلّ على البعير، والروثة تدلّ على الحمير، وآثار الأقدام تدلّ على المسير، فهيكل علويّ بهذه اللطافة، ومركز سفليّ بهذه الكثافة، كيف لا يدلّان على اللطيف الخبير"[3].
ثالثاً: أسلوب تنمية النزعة الحسيّة التجريبية
إنّ الإنسان بشكل عام كائن حسيّ أكثر من كونه عقلياً، فكيف بالطفل الذي يكون عنصر الإحساس عنده بارزاً وحاضراً بشكل قويّ؟ فالحسّ أقدر على تربية الإنسان من النظر العقليّ المجرّد، ويحتلّ من جوانب وجوده وشخصيّته وأبعاد مشاعره وعواطفه وانفعالاته أكثر ممّا يحتلّ العقل[4].
ويأتي دور المربّي في العمل على تنمية هذه النزعة الحسية عند الطفل، والأخذ بيده لكي يتعرّف على الكائنات المحيطة به وربطها ببعضها البعض.. ثم التدّرج ومساعدته على التفكّر في عجائب المخلوقات ودقائق صنعها، وقد اعتمد القرآن الكريم والنبيّ وأهل البيت على هذا المنهج الذي يفيد بأنّ الملاحظة الحسية والمشاهدة ومن ثمّ التأمّل والتدبّر والنظر في عجائب صنع الله تعالى، كالتأمّل في اختلاف الليل والنهار والنجوم وإحياء النبات... يثمر في معرفة الله تعالى وصفاته والارتباط به. ويعبّر عن ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة له، حيث يقول: "كفى بإتقان الصنع لها (أي للأشياء والمخلوقات) آية"[5].
وقد دعانا الله تعالى إلى التفكّر بالآيات الآفاقية والأنفسية يقول تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾[6].
وطريق معرفة الطفل بنفسه أيضاً من أهمّ الطرق في التربية العقائدية. ولا ينبغي للمربّي أن يغفل عن ذلك. وقد استخدم أهل البيت هذه المنهج في التعليم والتربية العقائدية، وكذلك تلامذة مدرستهم، فعن هشام بن الحكم قال: "إِن سَأَلَ سائِلٌ فَقالَ: بِمَ عَرَفتَ رَبَّكَ؟ قُلتَ: عَرَفتُ اللهَ - جَلَّ جَلالُهُ - بِنَفسي، لأَنَّها أَقرَبُ الأَشياءِ إِلَيَّ..... قالَ اللهُ عزّ وجلّ: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾[7]"[8].
فتنمية الحسّ التجريبيّ لدى الطفل في تعريفه على نظم الأشياء ودقائقها و... يعزّز في نفسه الإيمان بالله تعالى، وليس كما يظنه بعض الناس من أن تعزيز هذا الاتجاه يؤدّي إلى تغذية نزعة الإلحاد وإنكار وجود الله تعالى.
رابعاً: أسلوب التمرين على العبادات
من أساليب تربية الطفل على الارتباط بالله تعالى وتنمية حسّ الإيمان الدينيّ لديه جعلُه في سنّ التمييز (7 سنوات) وما بعدها يقوم بالأفعال العبادية كالصلاة والصوم والصدقة وغيرها... و"قد لا يفهم الطفل العبارات التي يؤدّيها في أثناء الصلاة، ولكنّه يفهم معنى التوجّه نحو الله، ومناجاته..."[9]. فالصلاة والصوم وغيرهما من ألوان العبادات تجعل الطفل يعيش حالة الخضوع لعظمة الله تعالى.
خامساً: أسلوب التربية على حبّ النبيّ وأهل البيت (عليهم السلام)
عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: "أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبّ نبيّكم، وحبّ أهل بيته، وقراءة القرآن..."[10].
ومن أنفع أساليب هذا النوع من التربية العقائدية للطفل قراءة قصصهم وسيرتهم عليهم السلام المناسبة للأطفال، كتحبيب النبيّ إلى قلب الطفل بإبراز كيفية تعامله العطوف الرؤوف الودود الرحيم مع ابنيه الحسن والحسين (عليهما السلام)... إلخ.
سادساً: أسلوب التربية على الإيمان بالمعاد
يكثر أن يسأل الطفل في المرحلة الثانية من طفولته أي منذ سن السادسة وما فوق عن الموت، وخاصّة إذا فَقَدَ أحداً من أقاربه فيسأل أين هو؟ وهل سيعود؟ وكيف نراه؟ ومن المهمّ أن نقدّم للطفل فكرة الموت بنحو يرتبط باستمرار مسيرة الحياة، ونصوّر له الأمر بأنّ الميّت يعيش في حياة ثانية وأّنّه يرانا ويسمعنا إذا دعونا له.. إلخ.
ويمكن الاستعانة على تفهيم الطفل فكرة الموت من خلال الأسلوب الحسيّ، فقد تناول القرآن الكريم هذا الأمر، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾[11], وغيرها من الآيات الكثيرة.
ومن المهمّ أيضاً تقديم يوم المعاد من خلال تصويره أنّه يوم حصاد للنتائج إمّا رسوب أو نجاح. ولكن ينبغي الالتفات إلى عدم تحويل الأمر إلى أسلوب تهديديّ للطفل بالعقاب الأخرويّ كأن تقول عبارة: "إذا فعلت كذا الله يخنقك"، "الله سوف يحرقك بالنار"... إلخ من العبارات، وهو كذب غير جائز حتّى في حقّ الطفل[12]، فإذا كان الله تعالى لم يوجّه إلى الطفل خطاب العقاب الأخرويّ فكيف للمربّي فعل ذلك؟.
[1] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص281، ح863.
[2] المبارك فوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410ه-1990م، ط1، ج4، ص46.
[3] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج3، ص55.
[4] السيد الصدر، موجز في أصول الدين، ص224-225. ويراجع: ص224-240، فإنه بحث لطيف حول الموضوع.
[5] الشيخ الصدوق، التوحيد، ص71.
[6] القرآن الكريم،سورة فصلت، الآية 53.
[7] القرآن الكريم،سورة الذاريات، الآية 21.
[8] الشيخ الصدوق، التوحيد، ص289.
[9] فلسفي، محمد تقي، الطفل بين الوراثة والتربية، ج2، ص150.
[10] السيوطي، الجامع الصغير، ج1، ص51.
[11] القرآن الكريم،سورة فاطر، الآية 9.
[12] السيد الخوئي، والشيخ التبريزي، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، ج3، ص298، س920.